بعد مرور أكثر من شهرين منذ التوقيع على اتفاق الرياض، لم ينفذ أي من بنوده سوى العودة المنقوصة للحكومة المبنية على رضا شبه تام من جانب رعاة الاتفاق السعوديين والإماراتيين؛ عن رئيسها الدكتور/ معين عبد الملك سعيد، وعلى اعتقاد راسخ بأنه سينفذ ما يتعين عليه فعله، وهو تأمين نفقات الطبقة السياسية والعسكرية الانقلابية الجديدة التي تأسست في عدن بدعم كامل من الرياض وأبو ظبي.
بحثت الرياض عن سياسي يمني ذي مصداقية لتزج به في أتون المحرقة السياسية التي أوقدتها في الساحة الجنوبية للبلاد، وهذا السياسي هو الدكتور أحمد عبيد بن دغر الذي ترك رئاسة الحكومة بطريقة لا تليق بدوره ولا مكانته ولا نضاله من أجل الانتصار للمشروع الوطني، ووقفته المشهودة في مواجهة المسعى الإماراتي الأكثر صلافة لاحتلال محافظة أرخبيل سقطرى في ربيع عام 2018.
اتسعت انتهازية الرئيس هادي لإلحاق الأذى المعنوي برئيس وزرائه رغم الصدمات الهائلة التي تحملها، حتى لا تصل إلى الرئيس القابع في الرياض رهن إقامةٍ جبريةٍ؛ لكن مترفة ومحاطة بالمغريات ومفتوحة على سلسلة من الصفقات التي لا تنتهي، وتجري إداراتها من قبل أبناء الرئيس، خصوصاً المتعلقة بتجارة المشتقات البترولية.
أرادت السعودية من وراء الزج بسياسي يمني يتمتع برصيد كبير في أوساط شعبه، لكي تضفي مصداقية على المخرج التكتيكي الذي حددته لتجاوز إشكالية التعثر في تنفيذ اتفاق الرياض وفق الجدول الزمني المحدد في الاتفاق، ولتظهر وكأنها معنية بإنجاح هذا الاتفاق الذي تسوق له باعتباره أبرز منجزاتها السياسية في اليمن.
حسناً، لقد وقَّعتْ الحكومة والمجلس الانتقالي مجدداً محضراً لاتفاق تضمن مصفوفة وجدولا زمنيا جديدا يمتد لعشرين يوماً، ويتعمد خلط الاستحقاقات السياسية والعسكرية والأمنية، بهدف وضع العربة قبل الحصان.
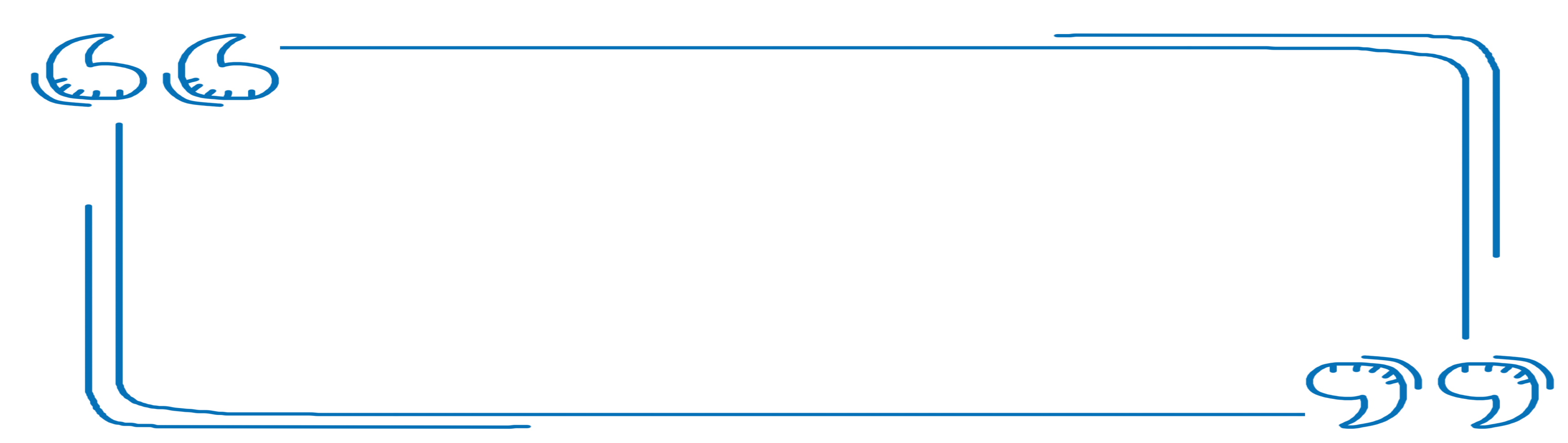
فالسلطة الشرعية لطالما حرصت على البدء بالترتيبات العسكرية التي من شأنها أن تجعل من العاصمة السياسية المؤقتة ساحة آمنة لتنفيذ الاستحقاقات السياسية؛ التي تقتضي بالضرورة عودة رئيس الجمهورية إلى المدينة.
وما يحدث اليوم هو أنه يجري الحديث عن انسحابات متبادلة، وتسليم أسلحة وتعيين محافظ ومدير أمن لعدن وتشكيل حكومة كفاءات، دون تحديد واضح لهذه الأولويات التي نص عليها الاتفاق.
وطبقاً لمعلومات ذات مصداقية، بدأت السعودية بالفعل باتخاذ الخطوات العملية للبدء بتنفيذ مشروع خط أنابيب نقل النفط وتصديره عبر مرفأ في محافظة مهرة على خليج عدن- بحر العرب، وهذا يشكل دافعاً أساسياً لتمسك السعودية ببقاء الرئيس هادي على أراضيها والحيلولة دون عودته إلى عدن، ولكي تمضي قدماً في تنفيذ مخططها الذي بات مكشوفاً لجهة استهدافه للمصالح العليا للشعب اليمني.
ومخطط كهذا لا يمكن أن تنفذه الرياض ما بقي رئيس البلاد حراً طليقاً ويمتلك خيارات اتخاذ القرارات التي تمليها المصلحة الوطنية، هذا إذا افترضنا أن الرئيس يحتاج إلى هذه الفرصة للتعبير عن إرادته الكاملة، والتي رأيناه يستعملها بشكل خاطئ منذ انقلاب 21 أيلول/ سبتمبر 2014، وإزاء الحروب الحوثية التي جرى التغطية عليها، والتي كانت تدور في مناطق تمتد من صعدة وحتى عمران، شمال صنعاء، قبل أن يصلوا إلى المدينة وينفذوا انقلابهم على الرئيس والسلطة الشرعية والعملية السياسية السلمية.
ويكفي أن انقلاب العاشر من آب/ أغسطس باعتباره جريمة سياسية وخيانة عظمى، بدلاً من أن تواجهها الحكومة الشرعية بالقوة القهرية، تجد نفسها مضطرة للتوقيع على اتفاق يمنح الانقلابيين وضعية متكافئة مع الحكومة في تقرير مصير الجنوب، وهو الهدف الذي تحقق للحوثيين في الحديدة تأسيساً على تفاهمات استوكهولم، مع فارق أن تلك التفاهمات لم تأخذ صيغة مكتوبة ولم يجر التوقيع عليها من جانب الحكومة والمتمردين الحوثيين.
المعلومات عن محضر الاجتماع الذي تم التوقيع عليه من جانب الحكومة والمتمردين الانفصاليين كشف عن تفاصيلها مستشار رئيس الجمهورية، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، الذي أوكلت إليه مهمة رئاسة لجنة سياسية تضم ثلاثة من مستشاري الرئيس.
التطمينات التي ساقها الدكتور بن دغر وتضمنت ما اعتبره إضافيا وجديداً كتسليم المهام الأمنية في عدن ومحافظتي شبوة وأبين للقوات الخاضعة للسلطة المحلية، ليست كافية للتصديق بأن ثمة نوايا حقيقية لتنفيذ الاتفاق أو ملحقه الجديد هذا.
لقد صُمم الاتفاق من حيث المبدأ لتعطيل قدرات السلطة الشرعية في المناطق التي اندحر منها الحوثيون، ولتفتيتها تدريجياً بحيث تتلاشى على إيقاع فشل ونقمة شعبية تنصرف بكاملها نحو الحكومة التي صممها التحالف وعمل على إفشالها طيلة السنوات الخمس الماضية.











