ثلاث سنوات مرّت قبل استشهاده لم يرَنا ولم نرَه، كل صلتنا به كانت بعض الرسائل والاتصالات السريعة نظرًا لسوء الخدمة في مأرب..
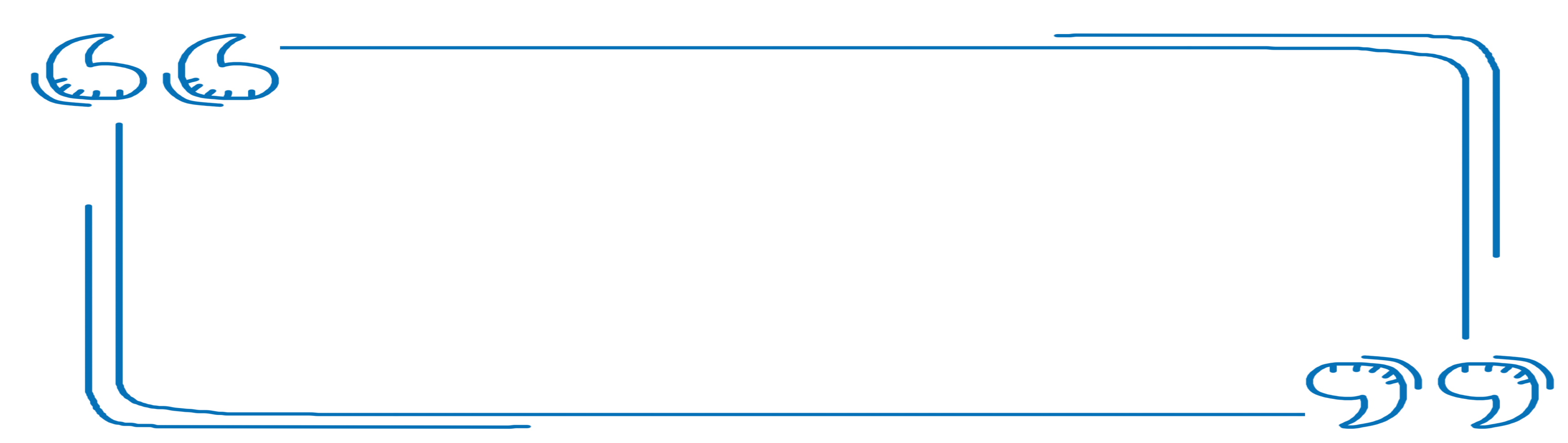
حدّثني بالهاتف اخر مرة بصوت مبتهج، ولسبب لم أفهمه كنت أشعر بالبكاء يخنق كلماتي المتقطعة..
ودعني بطريقته وأوصاني، وسألته كالمعتاد:
-»هل ستأتي لزيارتنا؟!»
ولأول مرة يقول لي بصراحةٍ:
-»لا..لن استطيع»
فسّرتُ الأمر باللحظة التي تحدث فيها لأنها كانت أيامًا صعبة والمعركة على أشدها، لكنه ربما كان يقصدها حقًا أنّه لن يستطيع..وقد فعل!
كان في هذه اللحظات منذ عام يتقلّد سلاحه ويفكر في شيء ما أبعد من أصوات الرصاص والمدافع، كان يعرف أنّ الأمر يزداد سوءًا وأن الجلوس والاختباء لن يُفيده ولن يُغنيه واندفع نحو الجبهة بشجاعة وإقدام يصول ويجول مواجهًا العدو ببسالة، يؤدي ما عليه رغم تعقيدات الموقف وتخاذل الجبناء.
مازلتُ حبيسة تلك اللحظة.. حين استوقفتني فجأةً صورة والدي على صفحة الصحفي سمير النمري وقرأت الخبر «أنباء عن استشهاد اللوآء الدكتور عبدالله الحاضري»..إلى الآن لازال ذلك الألم حيّا يكبُر مع الأيام ويصبغها بصبغته..
ما يهوّن علي الألم أنني متأكدة من أنه كان يعرف إجابات لكل الاسئلة المهمة.. كان يعرف من هوَ ! ولماذا يقاتل ! وبمَ يؤمن !
لأن أغلب الناس ينتشون في الحرب، لا يسائلون أنفسهم ساعة المواجهة واقتراب الموت، تتدفق الحياة في شرايينهم بشكل كثيف ومرعب، تزداد الحياة وضوحًا وأهمية كلما امتلك الإنسان هدفًا لا يتردد في أن يموت لأجله، وإن كان هذا السبب حقيقيًا فهذا فوز كبير، وإن كان سببًا واهيًا ضئيلًا فهو لا شيء أكثر من ساعة الحرب والموت دون أثر يذكر، لذلك كانت الأجوبة مهمّة ليمتلك سبباً أعمق وأدوم من عفوية الانخراط في التيار الهادر بلا أجوبة.
هذه الأسئلة ليست ترفاً، بل هي شرط ضروريّ لما سيأتي. وما سيأتي صعبٌ وقاسٍ، ولكنّ عاقبته مجيدة خالدة إن وافقت مُراد الله سبحانه.
ما يُشعرني بالإمتنان لقدر الله ولُطفه، أن والدي اختار طريقه على بيّنة ودراية.. ذهب لقدره ببصيرة مستنيرة، طلب الشهادة وأعطاه الله ما سأل في موقف عزّةٍ وشرف. اختاره الله وهو يقاتل مدافعًا عمّا يؤمن به، ورحِمَهُ سبحانه من ذلٍّ أذاقه للمختبئين من الحقيقة خلف ستار المشاورات وادعياء السلام الواهمين، هذا السلام المُلطّخ بالعار والدم والخذلان والهزيمة.
في السنوات الماضية، وفي الوقت الذي اقتنع فيه كثير منا بشعور عام بعدم الجدوى، كان هناك في ساحة المعركة يُحارب بصمود وشرف، لم يجعله الوضع الصعب يفقد إيمانه أو يتوقف عن عمله، كان يدرك أنه مُكلّف وأن السعي هو الغاية المطلوبة لا النصر مطلوب منه ولا تغيير الواقع بعصا سحرية، كان هناك مع الذين يحفرون الأنفاق بإيمانٍ وصبر، ويطوّرون بصمت الخنجر الذي سيغمدونه في صدر كآبتنا ويأسنا المُخزي، لم يكن يفعل ذلك ليتقاضى راتباً، لم يكن ينفذ الأوامر فقط، كان مؤمناً! ولم يكن محمولاً على يد الحماسة والقتال، بل على معنى السعي « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ..» قد تنتصر وقد تُهزم فهي معركة ولكن العمل عند الله لا يفنى ولا يضيع..
أعرف تمامًا أن ما جعله يصمد في المعركة هو شيء خارجها، شيء خارج نفسه التي بين جنبيه، وهو تعلّقه بهدف أكبر من الانتصار، وأبعد من أخذ الثأر. كان الإيمان بعدالة قضيته، والدفاع عن الوطن والأرض والحق، الإيمان بأهمية العمل والسعي بغض النظر عن شروط اللحظة وتعقيدها، الإيمان الملتصق بالعمل والعمل والعمل.. هذا الباعث الأول الذي لا يخبو ساعة النصر أو الهزيمة، ساعة الحزن والفقد، ساعة اختراق الرصاصات الجسد، ساعة الألم في ذروته وحين ينطفئ آخذًا معه الروح إلى فضاء آخر، فضاء أوسع وأرحم وأعظم مما قد يتخيله بشر، فضاءً لا يشبه كل ما نعرفه..تاركًا كل شيء..كل المعارك والانتصارات والخذلان والفقد والألم، تاركًا الأهل والوطن وحسرة اللقاء والحنين..الروح فقط وما تحمله في جوفها من معانٍ حقيقية.
اسأل الله أن يهوّن الدنيا في عينيّ كما هانت في قلبه ساعة الحسم، وأن يُثبّت إحساسي بأنها محض حُلم ننهض منه على جلال الحقيقة وعظمتها، فلا يهتز إيماني لحُزن ولا عارضٍ قُدّر علي ما حييت.
اللهم إني أشهدك أنه قد أحسن إلينا بما استطاع، ترك فينا أثرًا يذكرنا بحبك وبحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وبصلة الرحم. اللهم إنا نشهدك أنه كان يسعى في حاجة القريب والغريب، محب للعلم، شجاعٌ مقدام حازم لا يُداهن، حريص على فعل الخير ما منحته لذلك سبيلا.
فاللهم ارحمه واغفر له، وألحقه بالصالحين والشهداء في الفردوس الأعلى، وارزقنا الصبر والسلوان، واحفظ لنا ما تركه فينا من أثر طيب، واجعله في ميزان حسناته، والهمنا الرشد والحكمة من بعده
واجعل طريقنا استكمالًا لرسالته وتابعًا لطريقه، واجمعنا في مستقر رحمتك في جنّات النعيم.
قاتل الله الجبناء..
والرحمة والخلود لكل الشهداء












