إذا أحب العربي حزن، وإذا استبد به الشوق وقف على دار الحبيب فبكى وأبكى الديار والأحبة ورفاق الرحلة وأبكى الناقة والجواد، يقول المتنبي:
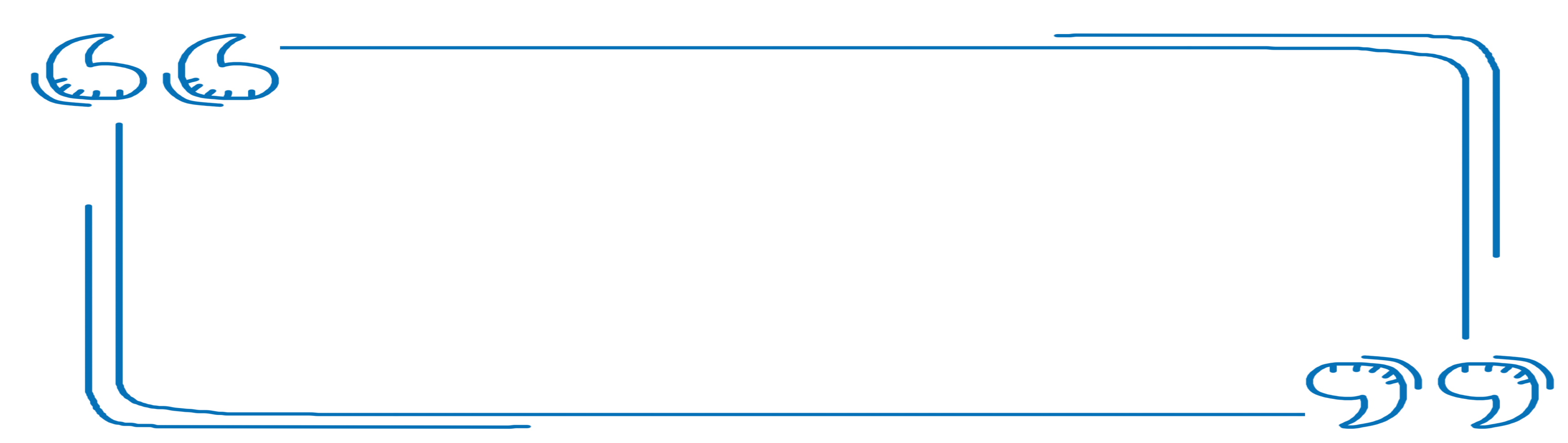
وقفت على دار الحبيب فحمحمتْ
جوادي وهل تُشجي الجيادَ المعاهدُ
والشاعر العربي القديم يبدأ قصيدته بالبكاء على الأطلال، لينتهي مادحاً الفرسان الذين تسببوا في جريان الدماء وهجرة الأحبة وخراب الديار، تماماً كما يبكي العربي المعاصر اليوم على خرائب وطنه في الوقت الذي يمتدح أمراء الحروب الذين دمروا هذا الوطن.
والعربي القديم الذي وقف يبكي على ديار الأحبة صور لنا أن بكاءه كان بسبب رحيلهم الذي ترك ديارهم طلولاً بالية، يقول امرؤ القيس:
ألا عم صباحاً أيها الطلل البالي
وهل يَعِمَنْ من كان في العُصُر الخالي
والواقع أن دواعي بكاء ذلك الشاعر كانت – بالإضافة إلى البعد العاطفي – مرتبطة بواقعه الصعب في حياة البادية، حيث ندرة الزاد وشظف العيش، ومخاوف الطريق، ومحاذير الغزوات المتلاحقة، والتزامات الحياة المعيشية، ومسؤوليات الخيمة والقبيلة، وغيرها من دواعي الهم والبكاء التي فجرها في وجدان العربي القديم وقوفه على طلل كان منزلاً لحبيبته الراحلة، وهو الطلل الذي لم يكن أكثر من الثقب الشعري الذي انثالت منه كل مشاعر الحنين والقلق والخوف وغيرها من مشاعر عبَّرتْ عنها قصائد الشعراء، وهي المشاعر التي لا تزال تعتمل لدى العربي اليوم.
وإذا قارنا بين حياة العربي القديم الذي بكى وأبكى في قصيدته وحياة العربي المعاصر الذي طور وسائل البكاء فإن بواعث بكاء العربي القديم ربما لم تتغير كثيراً لدى حفيده المعاصر، فالقديم بكى مِزَق الخيمة، والمعاصر يبكي شظايا الوطن، والقديم ركب الجمل وضرب به عرض البوادي بعيداً عن دياره، بحثاً عن مساقط المطر ومرابع الكلأ، والمعاصر ركب السفينة وضرب بها مغامراً عرض البحر في موجات هجرة ولجوء متلاحقة، في محاولة للوصول إلى الشاطئ الشمالي للبحر الأبيض المتوسط، بحثاً عن كلأ من نوع آخر، أو هروباً من ثارات بكر وتغلب وصفين وكربلاء.
والعربي الجد وقف مادحاً زعماء قبيلته والعربي الحفيد لم يبعد كثيراً عن سلوك جده، حيث لا يزال يكيل المديح للزعماء، في اختزال معيب للقيادة في شيخ القبيلة أو زعيم الدولة أو قائد الحزب، لدى كثير من الأحفاد الذين لم يعرفوا بعد أن شيخ القبيلة مجرد وظيفة لخدمتها، وأن القبيلة أهم من الفرد، وأن العرف أهم من الشيخ وأن القانون أقوى من الحاكم.
ورغم اختلاف ظروف الزمان والمكان إلا أن الرحلة تظل هي الرحلة والراحل هو الراحل، رغم الفوارق الزمنية والطبيعية بين ركوب الرمل وركوب الموج، بين ركوب الناقة وركوب السفينة والسيارة والقطار والطائرة، حيث تتجذر روح المغامرة، في محاولة للخروج من حدود المكان إلى سعة الأرض، ومن أطر الزمان إلى مساحات الأبدية.
ومن البكاء على أطلال فاطمة وهريرة وأسماء في قصائد امرئ القيس والأعشى والحارث بن حلزة إلى رثاء قرطبة وإشبيلية وغرناطة، وقصائد الراوندي والحضرمي والبلنسي، ومروراً بمراثي كثيرة قيلت في بغداد ودمشق والقاهرة وبيروت، وإلى خراب حلب وحمص والموصل والبكاء على ليبيا واليمن وقبل ذلك وبعده بكائيات فلسطين التي أضاعها أحفاد أولئك الذين أضاعوا غرناطة من قبل، ثم جلسوا يبكون على ضياعها قروناً طويلة.
لقد تطور البكاء على الديار القديمة إلى رثاء المدن الوسيطة إلى أن وصلنا إلى البكاء على الأوطان مع تطور وسائل القول وأساليب الكتابة من القصيدة إلى المقال. ومع انتقال محافل القول من سوق عكاظ إلى الصحافة والتلفزيون إلى مواقع التواصل الاجتماعي ظلت مواضيع فنون القول تلك متقاربة من بكاء على الأطلال إلى التفاخر والتهاجي والمديح السياسي والاجتماعي الذي تلون مع تنوع الفنون الأدبية والإعلامية، ومع تنوع منصات القول ووسائط الميديا المختلفة، حيث لم تعد البكائيات مقتصرة على القصيدة رغم أنها لاتزال تمثل دمعة كبيرة في «عيون الشعر» مع انشحان اللحظة العربية الراهنة ببكائيات لا تختلف عن خصائص «الوقوف على الأطلال» و«رثاء المدن» لدى الشعراء القدامى، وكل ما هو مختلف إنما هو الخصائص الفنية، والفروق الشكلية التي تحفل بالمضامين ذاتها.
ولمن أراد أن يتأكد من تشابه المضامين في القصيدة العربية القديمة وفي المنتج الإعلامي اليوم، سواء أكان نخبوياً (صحيفة، كتاب) أو شعبوياً (وسائل التواصل الاجتماعي) فما عليه إلا أن يقرأ ما يكتب ليطالع حجم الشعور بالوجع والتيه والوقوف على أطلال الأوطان التي مزقتها حروب عبس وذبيان، وصراعات ملوك الطوائف وأمراء الحروب، حول الماء والكلأ والسلطة والثروة.
لقد مرت القرون على سكان تلك الخيمة العربية، لكن معاناتهم لا تزال هي المعاناة التي عانوها في بواديهم الواسعة: حروبهم وغزواتهم، طبائعهم واهتماماتهم، انقساماتهم وخصوماتهم، سجالاتهم ومنافراتهم، تفاخرهم وتهاجيهم، كل ذلك لم يتغير في جوهره، وكل ما في الأمر أن وسائل الحياة هي التي تطورت، وتطورت معها أشكال وأنواع وأحجام المعاناة والصراع والانقسامات والخصومات، كما تطورت معها أساليب التعبير ووسائل النشر، مع بقاء «البدوي الصغير» كامناً في أعماقنا القصية التي نحاول أن نخفيه فيها بربطة عنق أنيقة لا تكاد تخفي أسمال ذلك البدوي الذي يجري منا مجرى الدم، متحكماً بالعقلية التي ظلت محكومة بتقاليد القبيلة رغم ركوبها الطائرة والقطار واستعمالها جهاز الآيفون وفتحها حسابات على الفيسبوك وتويتر واليوتيوب وتيك توك وغيرها من الوسائط الرقمية التي تعج بما كان يعج به سوق عكاظ من بكائيات ومنافرات ومفاخرات وهجائيات وغيرها من أغراض القول وفنون الكلام التي تعج بها وسائل التواصل التي أصبحت «عكاظاً إلكترونياً» كبيراً يتبارى فيه أصحاب الحسابات في إيصال أصواتهم للجمهور الواسع، حاملين المضامين ذاتها التي كان يحملها إلى سوق عكاظ القديم كل من امرئ القيس والنابغة والأعشى وطرفة وزهير وغيرهم من الشعراء.
ومع كثرة الأخطاء الكارثية التي لا زلنا نمارسها، ومع سيطرة تقاليد أجدادنا علينا، ومع سطوة حضور الماضي وثقل وطأته على حاضرنا، نشعر أن النقلة التي حققناها هي مجرد نقلة شكلية انتقلت فيها رسالتنا من طور «الحمام الزاجل» إلى «البريد العادي» إلى «البريد الإلكتروني» إلى رسائل الواتس والفيسبوك وتويتر، غير أن مضمون الرسالة التي نعرضها اليوم هو ذاته ـ مع بعض التحويرات ـ مضمون الرسالة القديمة، وأغراض المقال الصحافي اليوم هي ذاتها أغراض القصيدة العربية قبل الإسلام، حيث الدموع والشكوى واللوعة، دون التفكير في الحلول والإيجابيات والخروج من الدوائر المتكلسة ذهنياً وعاطفياً.
* القدس العربي












