-٣-
الجنوب: إرهاق الدولة بالصراع على الزعامة،
الشمال: سقوط الدولة في قبضة الزعيم:
المنحى الذي سار فيه انتقال الثورة إلى الدولة، كما شرحناه أعلاه، يكاد ينطبق في محتواه العام على الشمال وعلى الجنوب معاً بأشكال متفاوتة من التشوه، ومنهما الى القائد الرمز والأوحد.
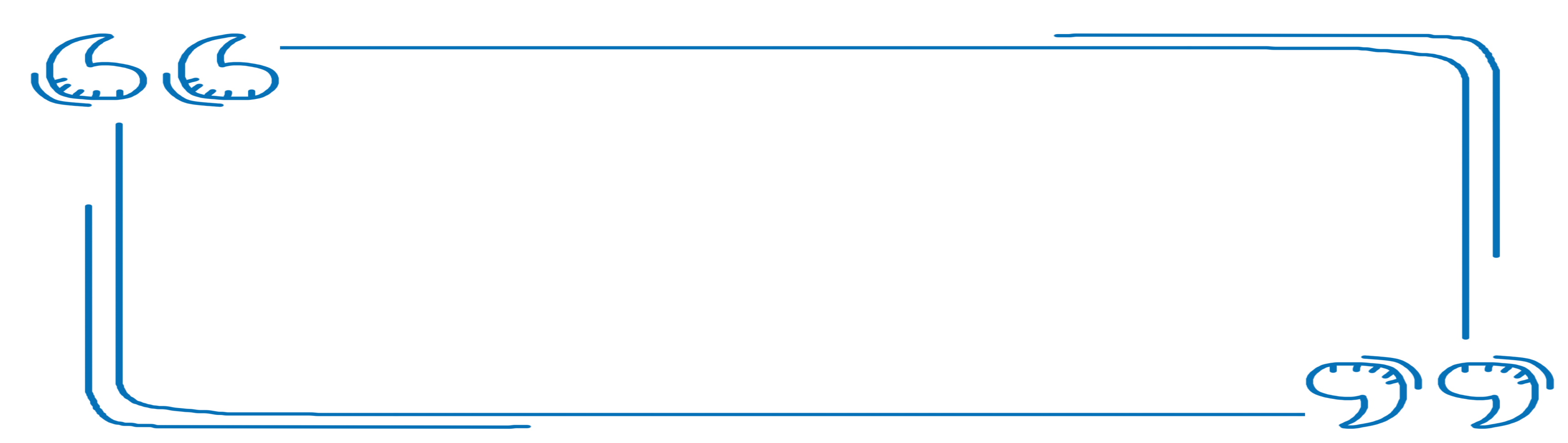
ففي الجنوب، على الرغم من أن الدولة في الجانب الاجتماعي ظلت تعبر عن روح وأهداف ثورة أكتوبر من خلال ما حققته من مكاسب اجتماعية واقتصادية للمجتمع عموماً، وللطبقات الكادحة والفقيرة على وجه خاص، ناهيك عن إقامة حكم محلي لا مركزي واسع الصلاحيات لحماية الوحدة الوطنية الداخلية التي كانت معرضة لصعوبات كثيرة بسبب أن الدولة كانت حاصل توحيد ٢٣ سلطنة وامارة ومشيخة ومستعمرة عدن، مع ما أحدثه التفاوت الثقافي والاجتماعي بينها من إشكالات ضخمة في بناء الدولة تم مواجهتها بنجاح في معظم الأحيان، إلا أنها، أي الدولة، في الجانب السياسي لم تستطع أن توجد الصيغ السياسية القادرة على خلق نظام حكم مدني، تعددي، متماسك بحيث يصبح معه انتقال الثورة الى الدولة انتقالاً طبيعياً لا يتعسفه القرار الفوقي التحكمي.
وقد يكون لذلك أسبابه بمنطق ذلك الوقت، إلا أنه في سياق تقييم الأسباب التي عطلت، إلى حد كبير، الانتقال الناجح من الثورة إلى الدولة يعد سبباً رئيسياً فيما أصاب ذلك الانتقال من تشوه.
إن الجانب الموضوعي لهذه المسألة يكمن في أن قوى الإنتاج لم تكن بالقوة التي تستطيع فيها أن توفر الشروط الاقتصادية الضرورية لانتقال مرن وطبيعي، ولذلك فقد استمر التدخل بأدوات سياسية، خشنة أحياناً، حيث نتج عن تلك القرارات الارادوية للانتقال من الثورة إلى الدولة صراعات استنزفت كثيراً من جهد الدولة والقيادة والمجتمع ككل.
وبسبب هذا الانتقال الذي حكمته شروط إرادوية تجاوزت ما كانت قد سمحت به الشروط الموضوعية لقوى وعلاقات الإنتاج، فقد أنتجت القيادة من داخلها نزعة إرادوية موازية أخذت تتجه نحو انتقال تدريجي للدولة ومؤسساتها إلى يد القائد الرمز يقفز فوق الحزب "القائد" ويتجاوز مكانته السياسية في سلم قيادة السلطة، وهو ما أدخل الدولة في صراعات الزعامة، والذي حسم في نهاية المطاف بتركيز أدوات السلطة كلها بيد أمين عام الحزب، والذي أصبح يقود الحزب والدولة معاً بعد محطات من الصراع أسهمت في الوصول إلى هذا الحل.
غير أن هذا لم يكن سوى محاولة لتفريغ شحنات الدولة لتسقط بكاملها في يد الزعيم.
وفي التوسط ما بين الدولة من ناحية، والحاكم أو الزعيم من ناحية أخرى، كان الحزب يقف حاملاً ميراث الثورة، ويعمل من موقعه ومكانته في البنية السياسية والثقافية للنظام لخلق ميزان لقياس ابتعاد الدولة عن الثورة، والتنبيه إلى ذلك بوسائل حزبية.
وقاوم بصلابة نزعة إنتاج الزعيم الأوحد بالاستناد إلى القاعدة التي تنص على أن الحزب هو القائد والموجه للنظام السياسي والدولة، وهذا يعني أن أي تعدّي على هذه القاعدة سيكون بمثابة انتهاك للقاعدة التي يقوم عليها النظام السياسي.
غير أن الاستجابة لمثل تلك التنبيهات غالباً ما كانت تصطدم بالتشابك في مواقع السلطة لقيادات الحزب، وما يرتبه ذلك من نفوذ للكثير من القيادات في مستويات مختلفة من إدارة الدولة، بما في ذلك الجمع بين قيادة الحزب وقيادة الدولة على المستوى المركزي، وعلى النحو الذي أخذ يجر الدولة إلى مخاطر الصراعات التي ما كان لتتوقف عند جناح في الحزب وإنما بيد القائد الرمز الذي يقود أياً من هذه الأجنحة.
وكان يتم الاستناد إلى هذا الوضع في تكوين تحالفات، وأجنحة، استعداداً للمواجهة وتمرير قضايا ذات طابع حاسم في قيادة السلطة.
لذلك فقد جرى استقطاب جزء من جهد ودور الحزب في هذه العملية التي تمحورت حول خلق الزعيم والقائد الرمز على النحو الذي تشكلت معه بؤر الصراع في أهم مؤسسات الدولة.
ولقد عكس الانقسام الرأسي للحزب في مؤتمره في أكتوبر عام ١٩٨٥ (بنسبة ٥٠٪ إلى ٥٠٪ بين الجناحين المتصارعين، والذي انعكس بدوره على الدولة وعلى المجتمع لأول مرة بصورة أشد وضوحاً مما كان عليه الأمر في مرات سابقة.
وكان أن جسدت هذه التجربة نموذجاً من التجارب التي أخذت تجر البعد الوطني للعدالة الإجتماعية للنظام السياسي، بما وفره من شروط لبقاء الدولة في حرم الثورة، إلى مزالق التفرد بالقرار السياسي من خلال عدد من العوامل التي كان من أبرزها العودة إلى تعبئة البنى الإجتماعية التقليدية لتطويق الحزب ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وهو ما شكل خللاً كبير في بنية النظام السياسي والاجتماعي، وانقساماً وطنياً انعكس على الثورة والدولة، ولا زالت آثاره توظف حتى اليوم في محاولات لتفكيك الجنوب، أو تغيير هويته، لضرب ثورة أكتوبر في الصميم.
أما في الشمال فقد كان ٥ نوفمبر ١٩٦٧ بمثابة إنقلاب حقيقي على سبتمبر، وهو الانقلاب الذي سُلِّمت فيه الثورة لهجين من القوى التي لم يكن الكثير منها يحمل وداً للثورة، ومعه فقد كان لا بد أن تأتي الدولة تجسيداً لهذا التركيب الهجين الذي لا يرى الثورة سوى محطة انتقالية بين النظام الملكي والجمهوري دون مضامين ثورية، سهلت الصراع على السلطة والانتقال بهما معاً إلى يد الزعيم القائد الذي خرج هو الآخر من وسط أنقاض الانقلابات والصراعات الدموية المتكررة، وانتهى بدوره إلى الاستعانة، ليس بالقبيلة كما يقال، ولكن بنظام شبه قبلي متوحش وهجين أفسد القبيلة وقمع قيمها، لترسيم حدود الدولة في الخارطة السياسية والاجتماعية مع ذلك النظام شبه القبلي وما ترسخ فيه من اعتقاد من أن الثورة ثورته وأن الدولة دولته، وهو الأمر الذي أفضى بعد عقود من عمر الثورة إلى استكمال تهميش قيم الثورة والدولة معاً في البنية السياسية للدولة بكافة مؤسساتها التي تداخلت بقوة مع ذلك النظام شبه القبلي في أكثر صورها تعصباً لبنى ما قبل الدولة.
وزاد من حجم المشكلة أن النظام بركائزه المختلفة وظف تاريخ الصراع السياسي الديني في مسألة الحكم توظيفا انتهازياً ليستقر عند حكم تحكمي يقوم على أن دولة المواطنة المدنية الديمقراطية مخالف للشريعة الإسلامية في تفسير اعتباطي لمفهوم فصل الدين عن الدولة، وكان الهدف من ذلك تكريس نموذج للحكم يقوم على أيديولوجية إحكام قبضة الحاكم المستبد على الدولة.
يتبع الحلقة الرابعة والأخيرة وكل عام وأنتم بخير، وأكتوبر مجيد.












