ثلاث من السنين مرت لم نتغير فيها كثيراً إلا بمقاسات الزمن الذي تستغرقه القلوب المهاجرة حتى تعود إلى أعشاشها، ذلك الزمن النفسي الذي يمكن أن تمتد فيه لحظة واحدة لتغطي صفحات أزمنة متطاولة تمر مضغوطة في اللحظة التي تتملكنا فيها دهشة أو نشوة أو جذبة في حضرة محبوب أو كتابة أو كتاب .
يقول فنان اليمن أبو بكر سالم بلفقيه «الزمن ما تغير» الزمان والمكان ظرفان، ونحن نملئهما بالأحداث والضجيج والصور. نحن الذين نتغير: أفكارنا، مشاعرنا، مصالحنا، وطرائق عيشنا، أما الزمن الخارجي فهو ذلك الجسر الثابت المعلق بين ضفاف الأنهار وشغاف القلوب، في حين أن الزمن الداخلي هو النهر المتدفق تحت الجسر، وهو نهر الأحداث والأفكار والمشاعر والرؤى والطموحات والأحلام والمسافات وأجنحة الطائرات المحلقة في الأفق البعيد .
وإذا كنا تغيرنا فإن الزمن وأحداثه لم يتغيرا تغيراً جوهرياً في منطقتنا، التغير تم في القشرة الخارجية، أما جوهر الأحداث فقد ألفتها شعوب المنطقة منذ أزمنة بعيدة .
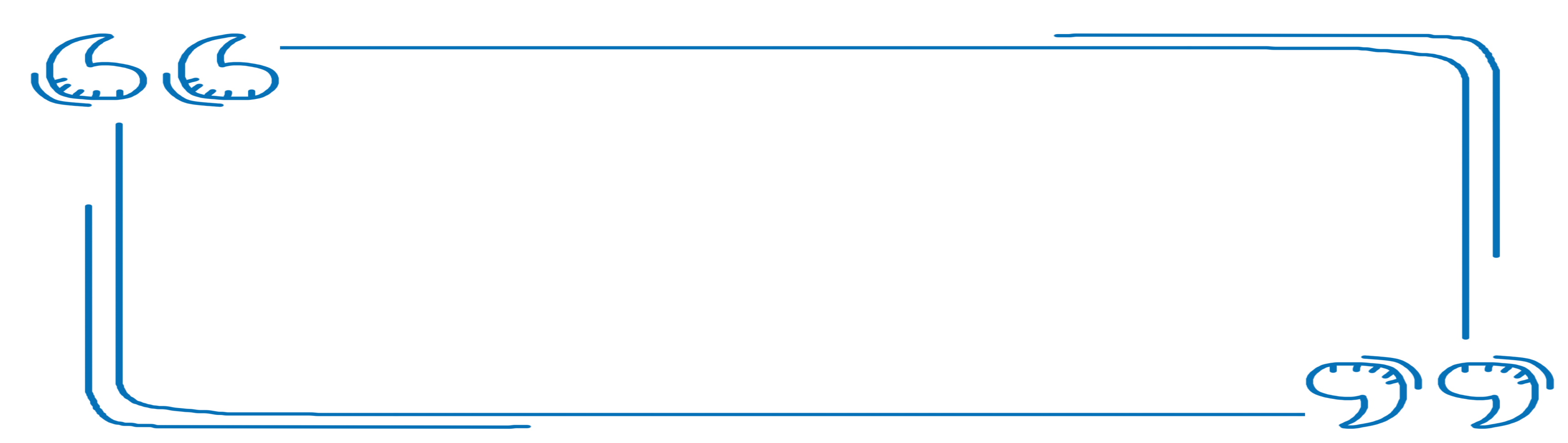
تركت العمل الصحافي في «القدس العربي» أواخر 2018 وهأنا أعود إليها كاتباً بعد حوالي ثلاث سنوات لم يتغير خلالها شيء ذو بال، داخل تلك الخيمة الممتدة من المحيط إلى الخليج، ومن الحرب إلى الحرب، الخيمة المتقلبة بين رمح جساس بن مرة البكري وظهر كليب بن ربيعة التغلبي، وبين قميص عثمان بن عفان ودم الحسين بن علي، الخيمة المهجوسة بـ» يا لثارات كليب» قبل الإسلام، و» يا لثارات الحسين» بعد الإسلام، والتي شهدت صرخات ثوار ومتمردين، وخلفاء وأئمة، وأمويين وعلويين، وعرب وفرس، وروافض ونواصب، وميليشيات وجماعات، ووطنيين ومرتزقة، برايات مختلفة قديماً وحديثاً .
لم يستجد جديد بالنسبة للزمن الخارجي: العراق هو العراق وسوريا هي سوريا واليمن وليبيا كذلك، ولا داعي للقول بأن فلسطين هي فلسطين. حتى «قلق مجلس الأمن» لم تتغير لغته بخصوص بلداننا التي تعد نسخاً كربونية من بعضها بمعايير التاريخ والتقاليد والسياسة، وكلها في «الهم شرق» وحروب وانقسامات رأسية وأفقية، لأنها بلدان تمثل رقعة شطرنج يلعب فيها الصغار حسب القواعد التي وضعها لهم الكبار الذين يمارسون اللعبة بأيدي حكام وميليشيات وزعماء حروب ومعممين ورجال طوائف وشيوخ عشائر محليين تضيع في معاركهم ملامح الشخصية العربية، وتتفتت – بفعل حروبهم – الأرض والمجتمع، وتضرب – بسبب جمودهم – تشظياتُ الماضي في قلب الحاضر، ويستمر اللطم على الحسين، مولداً المزيد من الاحتقانات الطائفية والثارات والأحقاد، التي تسهم في انسكاب دموع كثيرة ودماء أكثر .
خلال الفترة الماضية سافرت كثيراً والتقيت بأصدقاء وتساجلت مع خصوم، ودخلت في مشاكسات، ولقيت سفراء ووزراء وسلمت مرة واحدة على رئيس بلادي الذي طالبته كثيراً بالعودة إليها دون جدوى .
أذكر أنني خرجت من بلادي عام 2001 بنيّة العودة إليها بعد أربع سنوات، وهأنا أكمل عشرين عاماً وأنا أحدث النفس بالعودة إلى وطن نصحت رئيسه بالعودة إليه، كي لا يكرر تجربتي التي إن جازت لطالب تغرب عن وطنه، فإنها لا تجوز لرئيس بعيد عن شعبه .
تكمن مشكلة المتغرب عن وطنه في أنه لا يدرك أنه يتغير مع الزمن وأن الوطن نفسه يتغير كذلك بشكل يغيب فيه الانسجام مع تعاقب الليل والنهار .
وخلال السنوات الثلاث الماضية قمت بأعمال كثيرة رضيت عنها، واجترحت أعمالاً أكثر لم ترضني، وأعمال أخرى في حكم المشاريع المؤجلة، وبعد ذلك كله هأنا أعود إلى الكتابة، إلى ثمانية وعشرين صديقاً يشكلون عالمي الذي أهرب إليه من وجع السفراء والوزراء والرؤساء ومن نشرات الأخبار والحروب المتفجرة على شاشات القنوات الفضائية. ومع كل ذلك، يؤسفني أن أقول إنه لا جديد أعود اليوم به، الجديد هو القديم، وخبر اليوم هو خبر الأمس، وحكايات أوديسيوس هي أقاصيص سندباد في هذا الزمن الدائري الذي تتشابه أحداثه ومجرياته وبداياته ونهاياته وأيامه ولياليه .
كنت في الصحيفة قبل سنوات أتابع أخبار اليمن والخليج وبعض الأخبار الدولية، وأتواصل مع المراسلين وأدخل معهم في طاحونة المستجدات اليومية، وبعدها قررت أن أجرب عملاً آخر، ثم التحقت بالسلك الدبلوماسي لليمن، وجربت حظي من اللقاءات الرسمية، والكلام المعلب، واللغات المصنوعة من الكونكريت والبسمات المطاطية التي لا أرى فيها أثراً لبسطة الوجه وتدفق الروح .
واليوم أعود للحروف من سآمة وجوه بلاستيكية كثيرة، أعود ولو بكتابة مقال رأي بدلاً من الانغماس اليومي في الأخبار والأحداث والجدل الصحافي الذي لا ينتهي في السياسة والدين والثورات والربيع العربي الذي أعقبه خريف تساقطت فيه كل الأوراق، وبرزت أشجاره عارية من الأوراق التي حاولنا بها أن نواري سوءاتنا كما فعل أبوانا آدم وحواء، قبل أن يهبطا بنا إلى الأرض ليكون نصيبنا منها هذه الرقعة التي تعلمنا أنها ملتقى الحضارات العالمية، والمصالح الدولية التي بسببها وعلى أيدينا تحولت رقعتنا من الأرض إلى موجات دماء وهجرة ونزوح وتغريبات تراجيدية في كل بلد من بلدان هذه الرقعة التي يمارس فيها الكبار هوياتهم الكريهة .
تمر بالكاتب فترات يحس فيها أنه سجين قارورة حبره، ثم يقفز خارجاً من لغته لينطلق بعيداً عن سجن القارورة، ليكتشف فيما بعد أن الحرية الحقيقية لا تكمن إلا داخل تلك القارورة الصغيرة، وهذا بالضبط ما حدث لي بعد أن غادرت إلى بيئة أخرى حاولت قدر المستطاع فهمها وتلمس ملامحها، بيئة تشبه محلات الورود البلاستيكية بلا رائحة، فيها بسمات مرسومة بعناية على شفاه اصطناعية، تشبه بسمات مضيفات طيران ما زلن تحت التدريب، وفيها لغة مصطنعة تشبه قوالب الجبس، تتكرر فيها ألفاظ «سعادة السفير ومعالي الوزير وفخامة الرئيس» وهي الألفاظ التي أحس وأنا أنطقها بإحساس من يلوك الحصى وقوالب الثلج بأسنان نخرها السوس .
إنها مأساة الكاتب عندما يظن أنه يكسب حريته بمجرد الخروج من قارورة الحبر الصغيرة، فلا يلبث أن يجد نفسه مختنقاً بربطة عنقه التي اختارها بعناية قبل تلبية دعوة إلى حفل استقبال أقامه السفير الفلاني على شرف الوزير العلاني .
تواجه الكاتب صعوبات عديدة عندما يعمل دبلوماسياً، ومعظم هذه المعوقات تنبع من كون طبيعة الكاتب قائمة على الإفشاء والتعبير، في حين تميل الدبلوماسية إلى الكتمان والتحفظ، وهنا يعيش الكاتب تجربة قاسية منقسماً بين عالمين: عالم الشعب وعالم الحاكم، عالم الفكرة وعالم الممارسة، عالم القيم التي تعكسها الكتابة وعالم المصالح التي تمثلها الدبلوماسية، عالم الحرية والعفوية التي يمنحه إياها ثمانية وعشرون صديقاً هجائياً مقابل التصنع والتكلف الذي يفرضه عشرات الأصدقاء والزملاء في البيئة الجديدة ممن يرددون كليشيهات لغوية جاهزة ومملة إلى حد كبير .
ما علينا، ها نحن نعود للحروف والأفكار، للقراء والأصدقاء والعوالم الحميمية، وقارورة الحبر والسجن الذي قال عنه يوسف إنه أحب إليه من بهرج اللقاءات والحفلات في «قصر العزيز» حيث يمثل السجن خلوة الروح وصفاء الذهن وزاوية التصوف وديار الأحبة بعيداً عن أصحاب السعادة والمعالي والفخامة، وبعيداً عن لغة القلق اليومي لمجلس الأمن الدولي .
وقديماً نُسب إلى امرئ القيس بن حجر قوله :
وقد طوّفتُ بالآفاق حتى
رضيت من الغنيمة بالإياب












