أولاً :- مدخل تعريفي .
الدين في جوهره ، يعني الاستسلام الشامل ، والعبودية لله والخضوع التام له في جميع مناحي الحياة ،و النشاط الإنساني ، والسياسة هي القيام على الناس بما يصلحهم في دينهم ودنياهم ، وفي صحيحي البخاري ومسلم أن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ ) قال النووي رحمه الله يعني : يَتَوَلَّوْنَ أُمُورهمْ كَمَا تَفْعَل الْأُمَرَاء وَالْوُلَاة بِالرَّعِيَّةِ , وعرفها ابن نجيم بقوله " السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي " وعرّفها ابن خلدون بأنها " حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة ، فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به "
وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه الرشيد ، وفي تدبير شئون الدولة ؛ لأن شريعته قائمة على تحقيق المصالح وتكميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها وعلى هذا السبيل خلفاؤه الراشدون ، ومن بعدهم من صالحي ولاة المسلمين ،
ثانياً :- العلاقة بينهما .
السياسة في المفهوم الشرعي ، جزء من الدين ، لا تنفك عنه ، والعلاقة بينهما مبنية على الترابط بين الكل والجزء أو الأصل والفرع ، فهي حارسة و خادمة لمصالح الدين والدنيا فإذا اختل الأمر، وسخر الدين لخدمة السياسة ترتب على ذلك جملة من المحاذير منها :-
١ - انحراف السياسة ، في جانب التدين ، القائم على الخضوع التام والانصياع للوحي وتَحُوُل السياسي إلى الانتهازية أو استعمال الدين كذريعة للوصول إلى مكاسب دنيوية محضة أو أغراض سياسية آنيّة ، وذلك منافٍ لمعنى التعبد الخالص لله ، والسلوك الإيماني ، الذي أراده الشارع من المكلفين ،
٢ - الاضطراب في المسار السياسي وتناقض المواقف ، وضبابية الرؤية - وغياب الأهداف السامية ، نظراً لاختلال الموازين وفقه الأولويات - عند تعارض المصالح ، لطغيان أولوية الأطماع والمنافع الدنيوية والسياسية ، وتقديمها على المصالح الكليّة ومبادئ الدين وقيمه وأحكامه ، خلافاً لما تقرر في منظومة السياسة الشرعية ،
٣ - نفور كثير من الناس ، وفتنتهم ، وعزوفهم عن التقيد بمبدأ الربط بين الدين والسياسة ، فيبحثون عن سبل يرون فيها - حسب فهمهم - تبرئةً لضمائرهم من مثل هذه السياسة النفعية ، أو صيانة الدين من تلطيخه بأدرانها ، ومن ثم عزله في عالم القداسة الروحية ، والإعراض عنه ! كما فعل أرباب الديانات السابقة ، بسبب التحريف ، واستغلال الكهنة ورجال الدين الذين قاموا بتوظيفه لمطامع وأغراض منافية لمقاصد الدين ، ومن ذلك الاعوجاج ولدت العلمانية في الغرب ، ثم سرت عدواها بشقيها العنيف والمجاهر بمعادات الدين ، أو الناعم المتصالح مع الدين ظاهرياً ، لكن في عالم الروح والوجدان ليس إلا - دون القبول به مهيمناً على شئون الحياة - وإنما عزله بين جدران المساجد ، وهو ما يعني تجزئة الدين ، أو الإيمان ببعضه والكفر ببعضه الآخر أو التسليم به في باب العبادات وتركه في باب الحكم والتشريع والسياسات ، غافلين أن الشرك كما يكون في العبادة ، أيضاً يكون في الحكم والتشريع ( وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ) ( وَلَا يُشْرِكُ فِى حُكْمِهِۦٓ أَحَدًا )
ثالثاً :- خصائص السياسة .
يتميز الدين الإسلامي باعتباره الدين الخاتم الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه بجملة من الخصائص في باب السياسة الشرعية ومنها :-
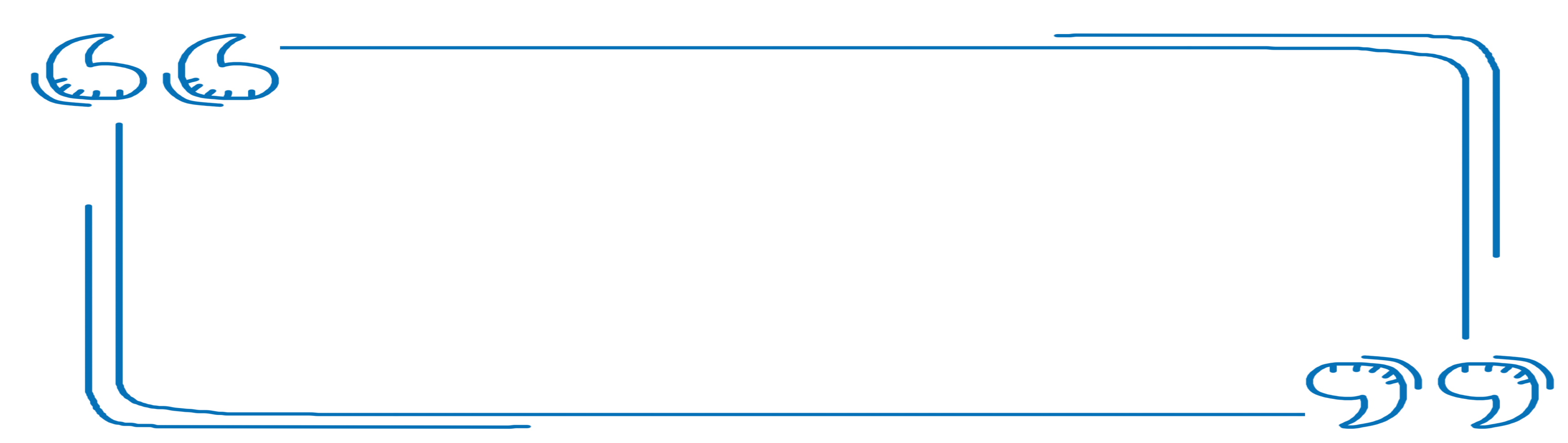
١ - خاصية الربانية .
وذلك باعتبار مصادرها ومضامينها ، القائمة على الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكن هنا أمور تفصيلية ذات صلة بجانب السياسات وصلتها بالدين عند الحديث عن خاصية الربانية يتعين الوقوف عليه :
أ - هناك بلا شك مفاهيم ومضامين ، لا يجوز أن تكون محل جدال أو اعتراض لا على المستوى السياسي ولا غيره باعتبارها مضامين ربانية ، قد حسمتها النصوص الشرعية على وجه ليس للمكلف فيه سوى التسليم والانقياد، سواء كانت هذه المضامين قد دلت عليها النصوص القرآنية ، أو السنة النبوية الصحيحة الصريحة - وبخاصة - ما هو منها محل إجماع بين المسلمين ، فالتراجع أوما يسمونه القراءة الجديدة لمثل ذلك يعد خللاً بيناً وضرباً من الشقاق أو التولي عن مراد الله، بحسب نوعه وأثره على الضروريات والكليات .
ب - هناك مضامين ومفاهيم منزعها يعود إلى النصوص لكن لا على وجه القطع واليقين وإنما على جهة غلبة الظن والترجيح ، ومثل هذه المعاني التي قد يسوغ النقاش والأخذ والرد فيها ، ينبغي النظر إليها من ثلاثة أمور منها :-
ج - الذهاب إلى ما ترجح فيها لدى الغالبية من المختصين في علوم السياسة الشرعية ، وهو الأقرب إلى السلامة والاحتياط، والفرض في حق ذوي السياسات الرجوع لأهل الاختصاص إن لم يكونوا من أهله كما يفعلون مع التخصصات الأخرى ، وحينئذٍ يعطى القوس باريها .
د - تسويغ العدول عن ذلك شريطة أن يكون هذا العدول قد نتج عن تجرد وإخلاص وليس عن متابعة للأهواء ، ويضاف إلى ذلك أن يكون لدى من سلك هذا المسار آلية صحيحة وأدوات من شأنها أن تؤهله لهذا الاختيار ، وهذا بضد ما نراه اليوم في كثير من المداولات السياسية ، من الميل مع التشهي والترخص بمبررات واهية لا تتناسب مع جانب التوقير لخاصية الربانية والتعظيم للنصوص الشرعية بحجة التسييس الذي هو أشبه ما يكون بالتلبيس .
هـ - يتعين في أبواب السياسات كغيرها ضرورة اطّراح الآراء الواهية ، والمنكرة والعدول عنها لما فيها من التعارض مع ما هو أصح منها وأوضح دلالة وضرورة بيان مثل هذه المضامين الشاذة وهجرها وعدم نسبتها إلى الشريعة الربانية .
وينبغي - كما حصلت جهود كبيرة - في غربلة كثير من كتب الحديث وبيان صحيحها من سقيمها وفق معايير أهل الصنعة من المحدثين - كذلك أن تبذل جهود من ذوي التخصص والاجتهاد لغربلة كتب الفقه وهجر الآراء الشاذة المنسوبة والمدونة في كتب المذاهب الفقهية الفروعية .
وتأتي الأهمية هنا حتى لا تكون متكئاً لذوي الزيغ والانحراف الساعين إلى لبس الحق بالباطل وإقحام ما ليس من دين الاسلام بغرض التنفير عن الشريعة المقررة كتاباً وسنة ، ومن جهة أخرى لما تمثله بعض هذه الآراء من عنت وحرج يتعذر نسبته إلى الشرع أو لما تفضي إليه من توهين الانقياد أو زعزعة مفاهيم الناس بخلط الوحي بغيره .
٢ - خاصية الثبات والشمول .
باستيعاب متطلبات وتغيرات الزمان والمكان ، وذلك بالوقوف على مساحة المرونة في فقه السياسة الشرعية مع النوازل والمتغيرات والحوادث المتجددة المندرجة في عموميات النصوص إلى أقصى مداها دون الإخلال بمرتكزات الدين ومقوماته الأساسية .
٣ - خاصية التيسير والسعة .
بناء على أن مفهوم دائرة السياسة الشرعية أوسع بكثير من مجرد حصرها على دائرة المنصوص عليه من الشارع الحكيم ، بل الدائرة تشمل جميع مساحات المسكوت عنه والمباح ، والمصالح المرسلة والاستحسان، ونحو دلك مما لم يأت به دليل خاص ، وإن كان مندرجاً في عموميات النصوص وكليّاتها .
وبهذا التيسير والمفهوم الواسع يمكن الوصول لتجفيف منابع التوجهات الساعية إلى فصل الدين عن السياسة وبقية شئون الحياة ، بناء على زعمهم ضرورة احتياج الناس إلى قوانين وتشريعات حداثية تتنافى مع الإطار العام للتشريع الإسلامي ! وهو مسار متهافت ، لأنّ المسكوت عنه يعد في حقيقته إذن من الشارع وبخاصة ما له تعلق بمصالح العباد من القوانين والتشريعات البشرية المتجددة في مختلف مناحي الحياة مادام باعثها العقل المتجرد والنظر المصلحي غير المتناقض مع كليات ومقاصد الشريعة ، وقد قرر المحققون أنّ كل اجتهاد لا يخالف الكتاب والسنة ، وفيه تحقيق لمصالح الناس فهو داخل في السياسة الشرعية، باعتبارها نوعان ، توقيفية ، واجتهادية .
وقد نقل ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين مناظرةً جرت بين ابن عقيل الحنبلي و بعض الفقهاء القائلين: (لا سياسة إلاَّ ما وافق الشرع) حيث قال ابن عقيل : إن أردتَ بقولك: (لا سياسة إلاَّ ما وافق الشرع)؛ أي: لم يخالف ما نطق به الشرع؛ فصحيح، وإِنْ أردتَ لا سياسة إلاَّ ما نطق به الشرع؛ فغلط، وتغليط للصحابة، - يقصد ما جرى منهم من الاجتهاد في ضروب النوازل والسياسات ، والحوادث والأقضيات المتجددة - ثم قال ابن القيم-: وهذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضَنْك، ومعترك صعب، فَرَّطَ فيه طائفة فعطَّلوا الحدود، وضيَّعوا الحقوق، وجرَّؤوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرةً لا تقوم بمصالح العباد، وسَدُّوا على أنفسهم طرقًا صحيحةً من الطرق التي يعرف بها المُحِقَّ من المُبطِلِ، وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها أنَّها أدلة حقٍّ، ظَنًّا منهم مُنَافاتها لقواعد الشرع .
والذي أوجب لهم ذلك: نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة، والتطبيق بين الواقع وبينها، فلمَّا رأى وُلاَةُ الأمر ذلك، وأنَّ الناس لا يستقيم أمرهم إلاَّ بشيءٍ زائدٍ على ما فهمه هؤلاء من الشريعة أحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العَالَم، فتولَّد من تقصير أولئك في الشريعة، وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شرٌّ طويل، وفسادٌ عريض، وتفاقَمَ الأمرُ، وتعذَّر استدراكه .
وأفرط فيه طائفة أخرى فسوغت منه ما يُناقض حكم اللَّه ورسوله، وكلا الطائفتين أُتِيَتْ من قِبَلِ تقصيرها في معرفة ما بعث اللَّه به رسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنَّ اللَّه أرسل رسله، وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقِسْطِ، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العقل، وأسفر صبحُهُ بأيِّ طريقٍ كان، فذلك من شرع اللَّهِ ودينه، ورضاه وأمره .
ثالثاً :- تطبيقات خاطئة .
هناك ثلاثة أنواع من الإخلال في تطبيق علاقة الدين بالسياسة :-
الأول :- تسييس الدين، ومعنى ذلك القيام بتطويع النصوص الشرعية وليّ أعناقها وتوظيفها لخدمة السياسات والأهواء ، المختلفة، ثم الاستدلال على ذلك بالدين ونصوص الشرع ، لتوافق ما يريد الفاسدون ، وتسخير الأجراء من علماء السوء في ذلك والأمثلة في ذلك كثيرة .
الثاني :- الإخلال في تحديد مفاهيم التيسير والسعة ، ومنطلقات المرونة دون التقيد بضوابط الوقوف عند حدود الوسطية والاعتدال ، والتجاوز إلى مزالق الاعوجاج في السياسة ومنعطفاتها المختلة ، فالسياسة الشرعية لديها من المضامين الضرورية وفقاً لمعايير تحقيق المصالح ما يتناسب مع سلوك المناورة والتورية واستعمال المعاريض وتأجيل ما لا يتناسب مع زمانه وظرفه أو ما يكون ضرره أكثر من نفعه ، وما يسوغ فيه ارتكاب أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما ، وتفويت إحدى المصلحتين لتحصيل أعلاهما ، لكنها بالمقابل صارمة في مرتكزاتها ومبادئها وأخلاقياتها فليس من مرونتها تمييع مضامينها أو التلبس بمساوئ الأخلاق بحجة الكياسة ! كالغدر ونكث العهود أو الفجور في الخصومات ومجانبة العدل مع المخالفين فضلاً عن التماهي مع طرائق وأساليب التلون والكذب والنفاق والغش ، والفساد وغيرها من السلوكيات المنافية للعنصر الأخلاقي ، الذي يجب أن يستصحب ، في كل حال ، دون إخلال به الافي حدود الاضطرار ، وبما لا يؤدي إلى التمادي والاستغراق في الحالة الاستثنائية لتصبح القاعدة معكوسة .
الثاني :- الإخلال في تقرير العزوف عن الممارسات السياسية من منطلقات دينية وتقبيحها لما فيها من المكدرات وما تلبست به من السلوكيات والتطبيقات المنافية للمثل الأخلاقية والقيمية ومثل هذه المقاصد الحسنة - وإن بدت مقبولة - لما فيها من مسالك الطهورين ، إلا أن مآلها قد ساهم في تعميق فصل الدين عن السياسة ، ومناشط الحياة ، بما أوحى بشكل مباشر أو غير مباشر بأن الممارسات السياسات منافية للدين ، في عموم الأحوال لضرورة وجود مناخات صحية ، وبأنه يتعذر أن تتعايش معه - وبخاصة في عصرنا - وهو ما سعت إلى تجذيره وترسيخه التوجهات العلمانية ، والمحصلة هي الدعوة للانسحاب من أحد أهم جوانب الدين ومضامينه من ميادين العمل السياسي ، لصالح الجهات التي ما فتئت تسعى لعزل الدين عن واقع الحياة فاتفق الطرفان في المآلات واختلفوا في الوسائل والنيّات .
ختاماً :-
ومن المهم التنبيه على أنّ واحدة من أهم قضايا التشغيب على جانب ارتباط الدين بالسياسة ما يتعلق بالتعددات المذهبية ، حيث تثار بين حين وآخر مثل هذه الشبهة، وهي أنه إذا قيل بوجوب الربط بين الدين والسياسة وبقية شئون الحياة فالإيراد على أي مذهب يكون هذا الربط ؟
وقد اختلفت المذاهب وتشعبت ؟
وهي بلا شك شبهة واهية ، يكفي لنسفها تعاقب القرون على التحاكم إلى شريعة الإسلام حصرياً منذ صدر الإسلام فما بعده- رغم تعدد الآراء والاجتهادات المذهبية وغيرها دون وجود هذا الإيراد - ولو صح هذا الإيراد - وهو باطل - لكان الأولى بهذا الإيراد جميع المذاهب والنظريات الأرضية كالعلمانية ، والديمقراطية ، والاشتراكية ، والليبرالية لتعدد الآراء والمدارس المتناقضة فيها ، ويضاف لدى من قد تروج عنده هذه الشبهة لضعفه بالعلوم الشريعة الاسلامية ، أن يقال لإسقاطها : إن ما يجمع المذاهب الاسلامية وهو محل اتفاق بينها كثير وهو لُبّ الشريعة الإسلامية وقوامها ، المتعلق بالواجبات والمحرمات والحدود والسياسات العامة ، وأما المختلف والمتنازع فيه ، فمنه ما هو محل ترجيح لدى جمهورهم وكثير منه من الظنيات التي يجب أن تكون ضمن دائرة الخلاف المقبول - مالم يكن قولاً مهجوراً ومطّرحاً - ويمكن فهمها من جهة أنها مساحات كبيرة للسياسة والأحكام السلطانية ، وللأخذ منها بما يحقق المصلحة العامة للناس وبخاصة تلك الآراء التي تتعلق بالتيسير على الناس ، فيكون ذلك من تعدد السعة و الرحمة وبمثل هذا الجواب يسقط الأشكال الوارد من أساسه .
اللهم اهدنا في من هديت .












