يقول الفلاسفة إن الله خلق كائناً عظيماً واحداً، ثم بواسطته خلق المخلوقات جميعاً، في متواليات من التعدد والتنوع لا تنتهي، حسبما ذكر أفلوطين – لاحقاً ـ في نظرية الفيض.
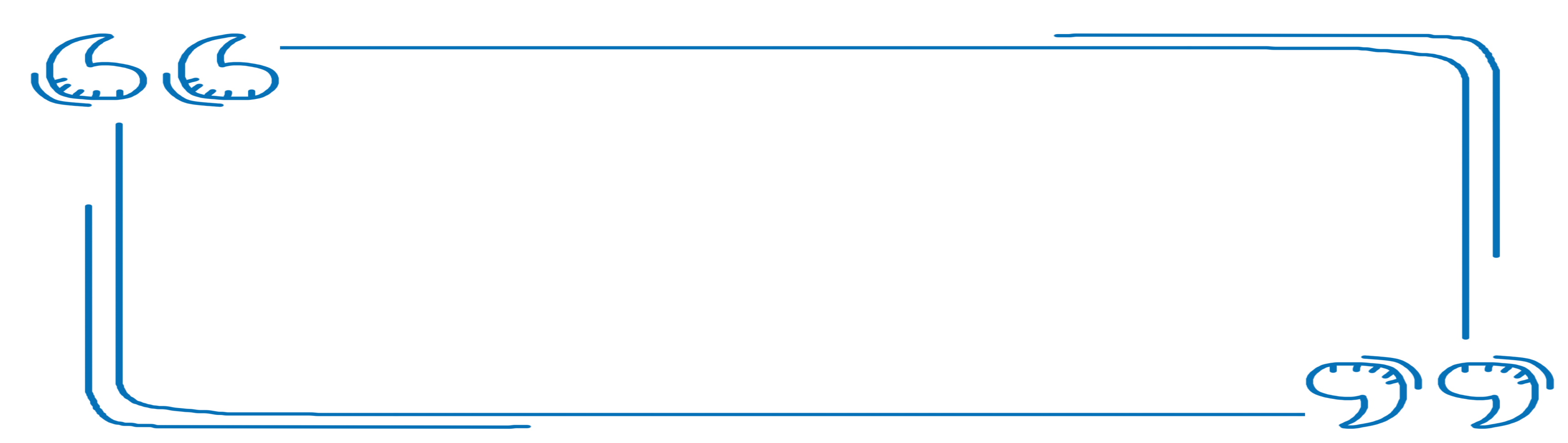
هذا الكائن أخذ تسميات متعددة، حسب التطور الفلسفي، أولها الـ«لوغوس» الذي هو القانون الإلهي الذي يتحكم في الوجود، عند هرقليطوس، ثم «العقل الفعال» عند الرواقيين، وهو الروح و«الكلمة» وهو الذي قالوا إن «الأول/الله» أبدعه ليكون وسيلته في إخراج الموجودات الكثيرة إلى الوجود، حيث تصور «استحالة صدور الكثرة عن الواحد» بشكل مباشر، وهو التصور الذي أفضى إلى تطور فكرة «الوسيط» أو «الوسطاء» الذين خلق الله بهم العالم.
ومع الزمن انتقلت الفكرة الفلسفية عن اللوغوس باعتباره وسيلة الإله في إخراج الكون إلى الوجود، انتقلت إلى الأديان، ليتخذ اللوغوس أسماء وأوصافاً جديدة، ووظائف مختلفة، ولتصبح وظيفته الدينية ليس مجرد تيسير «صدور» الكون عن الله، ولكن ـ كذلك ـ تيسير «ورود» الإنسان إلى الله عبر الوسائط، كما يقول الكهنوت الديني.
وقد طور الكهنوت الديني الفكرة الفلسفية عن صدور الكون عن الله عبر وسيط، طورها إلى عقيدة دينية، لم تكتف بضرورة وجود وسيط يبدع الله من خلاله الخلق، بل إن وجود هذا الوسيط ضروري ـ كذلك ـ لعودة الخلق إلى الله، وذلك لأن استحالة «ورود» الإنسان إلى الله دون وسيط، كاستحالة «صدور» الكون عن الله دون هذا الوسيط الذي يصل الإنسان الفاني بالإله الخالد، والذي يكون أعلى مرتبة من الإنسان، وأقل مرتبة من الإله، حسب بعض العقائد، أو يساوي الإله، في عقائد أخرى، وذلك بسبب تحول الأفكار الفلسفية إلى عقائد دينية، مع مرور الزمن.
ولاحقاً، اندمجت كثير من أفكار هرقليطوس والرواقيين ضمن كثير من العقائد الدينية اليهودية، وظهرت في بعض الأسفار أوصاف مشابهة لوصف اللوغوس الإغريقي، وذلك بالحديث عن «الحكمة» التي «تساعد الله في عملية الخلق» و«الكلمة» التي نجا بها الله بني إسرائيل. ورأى الفيلسوف فيلون اليهودي السكندري أن اللوغوس هو «الوسيط بين الله والناس».
أما المسيحية فقد دار كثير من عقائدها حول فكرة اللوغوس الإغريقية، وطور فلاسفة وكهان مسيحيون تلك الفكرة، بعد أن أدخلوها ضمن الكهنوت المسيحي، وأسقطوا صفات «اللوغوس الإغريقي» على «المسيح الناصري» فاللوغوس في المسيحية هو الكلمة، وهو «الابن المتولد عن الآب» وينص الإنجيل المنسوب ليوحنا على أنه: «في البدء كان الكلمة» ويرى يوحنا أنه «كان قبل خلق الكون، كان عند الله» وأنه «هو الله» أو هو الكلمة التي تجسدت، وحلت بين الناس.
وهنا يبدو واضحاً أن فكرة (المسيح/الكلمة) ما هي إلا ترجيع ديني مسيحي للفكرة الفلسفية الإغريقية عن اللوغوس، أو العقل، أو العقل الأول، أو الروح، أو غيرها من تسميات مهمتها التوسط بين الخالق والمخلوق، في انعكاس واضح لفكرة عدم قدرة الإنسان على التواصل المباشر مع الله إلا عن طريق الوسطاء، أو عجز الإنسان الفاني عن الوصول إلى الخلود الأبدي، دون وساطة، إلهية أو شبه إلهية، حسب نوعية المعتقدات، وقربها أو بعدها من فكرة التوحيد الإلهي.
وفي فترة تشكل اللاهوت المسيحي على صورته التقليدية المعروفة اليوم، وما قبل تلك الفترة كانت الأفكار الفلسفية عن الإله والوجود والثالوث والوسطاء الذين خُلق عبرهم هذا الوجود، كانت تلك الأفكار مزدهرة، وكان الفيلسوف أفلوطين السكندري يطور نظريته عن «الفيض» التي يرى فيها أن الوجود المادي «فاض» عن (الأول/الله) كما يفيض النور عن الشمس، وأن «انبجاس» الوجود عن «الأول» لا يمكن أن يكون بشكل مباشر، ولكن ذلك تم عن طريق (الروح/العقل) الذي فاضت عنه (النفس) عبر سلاسل طويلة من التحولات والفيوضات التي تشكلت في قوالب الوجود المادي، وبهذه الطريقة خرج «المتعدد من المتوحد» لأن خروج الجمع من الواحد لا يمكن أن يكون بشكل مباشر، ولكن عبر «وسائط الفيض» التي هي أقانيم فاضت عن الأول، وهي الأفكار التي طورها الفيلسوف المسلم الفارابي فيما بعد، محاولاً المواءمة بينها وبين المعتقدات الإسلامية، بعد أن قال إن «الأول» صدرت عنه عشرة عقول بالتدريج، وليس عقلاً واحداً، وصولاً إلى العقل الفعال الذي أخرج هذا الوجود المادي.
ويبدو أن الثالوث الأفلوطيني بأقانيمه الثلاثة (الأول والروح والنفس) تأثر ـ بحكم نشأة أفلوطين المصرية ـ بالثالوث المصري القديم عن (إيزيس وأوزوريس وحورس) وهذا الثالوث الأفلوطيني مع الثالوث المصري القديم كان له أثره ـ فيما يبدو ـ في تشكل الثالوث المسيحي التقليدي، بعد أن تم التخلص من كل الفرق المسيحية التي كانت ترى في المسيح طبيعة واحدة هي الطبيعة الناسوتية التي ليس فيها تأليه للمسيح، ليستقر الثالوث على صيغته التقليدية المسيحية في (الآب والابن والروح القدس) في تأثر واضح بأفلوطين السكندري الذي حاول تطوير مثالية أفلاطون، بالتحول من «الوجود المثالي» إلى «الوجود المادي» عبر الثالوث الأفلوطوني المقدس.
ويتدفق الزمان، ويأتي الإسلام الذي كان حاسماً ـ عبر نصوص القرآن ـ في نفي حكاية الوسطاء والشركاء في الخلق: «ألا له الخلق والأمر» ضمن عقيدة الإله الذي «لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك» وعن النبي الذي لا يعد وسيطاً بالمعنى الثيولوجي، ولا شريكاً لله، وإنما بشر يوحى إليه. وظلت تلك العقيدة التي تفصل فصلاً تاماً بين الخالق والمخلوق، وبين الله والإنسان تمثل جوهر المعتقدات الإسلامية إلى اليوم، عدا بعض الفرق الإسلامية التي تأثرت بأفكار فلسفية مختلفة مع نهاية القرن الهجري الأول، وما بعده، مع توسع حركة الفتوحات الإسلامية، ودخول أمم مختلفة الإسلام، أدمجت ثقافاتها وفلسفاتها في صلب عقائد تلك الفرق التي اعتنقت مزيجاً من أفكار فلسفية ذات جذور غير إسلامية، بعد أن لونتها بصبغة إسلامية، في محاولات لتكييف فكرة «الوسيط الإلهي» بين الله والإنسان.
وكان لفِرَق وفلاسفة متأخرين دور كبير في إدماج فكرة «اللوغوس اليونانية» ضمن معتقدات شيعية وصوفية متشعبة، جسدت الفلسفة القائمة على فكرة الوساطة بين الله والإنسان، عبر فكرة «الإمام صاحب الولاية التكوينية» عند الشيعة، أو فكرة «الحقيقة المحمدية» والأولياء والأقطاب عند المتصوفة.
والواقع أن فكرة الشيعة عن «الإمام» ليست أكثر من إعادة إنتاج للفكرة الفلسفية الإغريقية عن (اللوغوس أو الروح أو العقل) التي أُدمجت ضمن عقائد إمامية تقول بخلق الإمام قبل أن يخلق الكون الذي خُلق «من نور النبي محمد ونور الإمام علي» وهي ذات الفكرة الأفلوطينية عن صدور الكون عن «الأول» عبر الروح أو العقل، وذات العقيدة المسيحية عن أن المسيح كان مع الأب، قبل خلق الكون. كما تشير المعتقدات الشيعية إلى أن الإمام هو وسيلتنا للوصول أو العودة إلى الله، تماماً كما كان المسيح هو طريق الإنسان الوحيد للخلاص والوصول إلى الآب.
وكما تأثر التشيع بالفلسفة الإغريقية فإن التصوف جرت عليه السنن ذاتها، حيث اغترف المتصوفة وفلاسفتهم من منبع الفكر الفلسفي الإغريقي في كثير من أفكارهم، وما فكرة توسط الأقطاب بين الله والإنسان، وتحكمهم كذلك في الكون إلا ترجيع لأفكار فلسفية إغريقية، لا دينية إسلامية.
وهنا يمكن الحديث عن فكرة «الحقيقة المحمدية» وهي نور فاض عن الله قبل خلق كل شيء، وقبل أن يتخلق محمد عليه السلام نفسه على صورته الآدمية، وعن نور «الحقيقة المحمدية» صدرت الموجودات. يقول ابن عربي في «فصوص الحكم» إن «بدء الخلق الهباء، وأول موجود فيه الحقيقة المحمدية» التي يسميها كذلك «العقل الأول» أو «القلم الأعلى».
وهذه الأفكار التي ترى في محمد طبيعتين: نورانية قبل خلق الكون، وبشرية بعد ميلاد النبي إنما هي مجرد ترجيع للفكرة المسيحية عن المسيح ذي الطبيعتين اللاهوتية الإلهية والناسوتية البشرية، والتي هي بدورها انعكاس لنظريات الفيض والوسطاء التي وجدث لدى الفلاسفة الإغريق، قبل الإسلام بزمن بعيد.
ومن تلك الأفكار الفلسفية التي تسربت للأديان من الفلسفة حاول الكهنوت الديني توظيف الدين لصالحه، حيث شهدنا الكثير من المآسي والحروب والاستغلال المادي للأديان، بسبب وجود تلك الأفكار الفلسفية التي حولها الكهنوت إلى عقائد دينية، وظفها لصالحه.












