مقال اليوم ليس مقالاً، إذ كيف يمكن اعتبار قصائد الرثاء والهجاء مقالات؟ وكيف يمكن نشر البكائيات ضمن صفحات الرأي؟
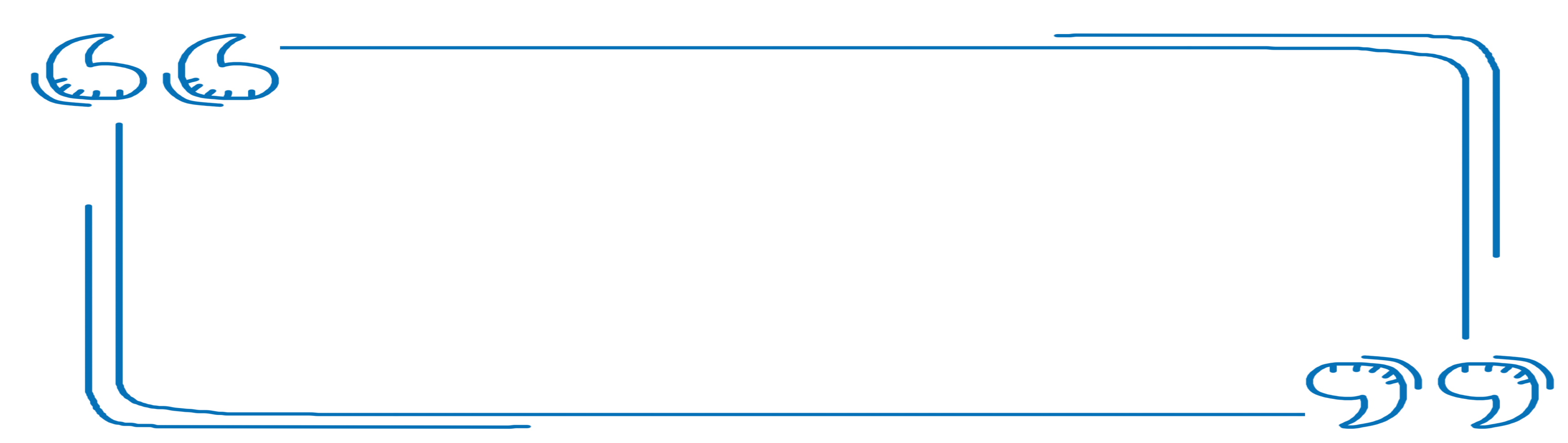
هذا ليس مقالاً، إنه بالأحرى حرف نازف، الحروف المضرجة بالدم يمكنها أن تكتب بكائية لحياة ما، لطلل ما، لمدينة مذبوحة، يمكنها أن تكتب أغنية تأتي من تحت ركام المدينة، لكنها لا تستطيع أن تشكل مقالاً يُفترض فيه التحليل وإعمال الفكر، لأن لون تلك الحروف القانية يمنعها من التماسك في حضرة الموت، إذ لا يليق مع الموت الكثيف إلا الرثاء.
ولكن، هل يجوز للكاتب الذي يكتب الرأي أن يكتب ولو مرة واحدة بكائية؟ هل يحق له في حضرة المذبحة أن يُنحّي عقله جانباً، ويقف – باكياً – على أطلال مدينة تنهش لحمها ضواري الأرض؟ مدينة تنتمي لعالم اليوم، وتتعرض لجرائم منتمية لعصور ما قبل التاريخ، على مرأى ومسمع ممن ينتمون لحضارة القرن الحادي والعشرين؟! هل يحق للكاتب أن يعترف أمام قرائه بآلامه؟ أن يسعد خصومه بلحظات شماتة، يعترف فيها بالانهيار الكلي، بالضعف المريع، بالعجز التام.
يعترف بالنكبة والنكسة، وكل ما في القاموس العسكري والسياسي العربي من مصطلحات ملطفة للهزيمة، هزيمة الكاتب الذي مل من تحبير الكلام، في وقت يسبح أطفال مدينة عربية في بحور دمائهم، وسط عجز السلاح عن نصرتهم، عجز الأقلام عن نقل جريمة القرن التي حلت بهم، وعجز الشاشات عن تغطية الجريمة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأفظع خلال القرن الحالي.
نعم، ها أنا أعترف: هزمتني غزة، هزمت قيمي، عواطفي، مشاعري، وامتحنت إيماني بشكلٍ لم أعان مثله من قبل، هزمتني أنا المواطن العربي الذي تربى على أن العرب أمة واحدة، وأن المسلمين كالجسد الواحد. هزمتني غزة وهي تكشف عورة مناهجنا التربوية التي علمتنا أن فلسطين هي قلب العالم العربي، تكشف تساقط أناشيد الطفولة وقصائد الشباب التي حفظناها عن ظهر قلب، تكشف تهاوي خطب الجمعة التي حدثتنا عن أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين. هزمتني وأنا أراها تواجه الموت عزلاء، محاصرة، جائعة، والعالم يذهب صباحاً لأعماله، ويؤوب مساء للحظات حالمة، كي لا يسمع حشرجات روح طفل فلسطيني يلفظ أنفاسه، ولا يرى أشلاء الأطفال المعجونة بتراب الأرض، ودمهم المسكوب الذي جعلني أخلع آخر أقنعة التجلد والصبر والتحليل المنطقي للأحداث.
لم أعد أقوى على ممارسة لغة المقال الرصين، يصبح التحليل السياسي في حضور دم طفل صغير، يصبح ضرباً من ممارسة الجريمة بدم بارد، يصبح ترفاً عقلياً لا قدرة لي عليه، يصبح تمظهراً بالمنطق في زمن لا منطق فيه، وفي عالم لا عقل في رأسه الكبير، عالم يشقى برأسه الكبير الذي أثقل جسده منذ عقود طويلة.
عشت فترة طويلة أحاول مداراة ضعفي إزاء قوة هذا المصير، أقاوم بسحنة وجه متجهم، وملامح تدعي الصرامة والجدية، لكن آخر كلمة قالها طفل غزاوي قبل أن يلفظ أنفاسه في غزة كانت القشة التي قصمت ظهر هذا الضمير، هذا البعير الذي أنهكه التنقل بين الفيافي والفلوات والسياسات والصحف والشاشات.
في نشرة المساء يظهر المذيعون والمعلقون المتحمسون بموازاة صور مصاحبة لجثث الأطفال في الرمق الأخير، صور أم تحتضن بقايا جثة، بقايا أمل، بقايا حياة، أو مُسنّ يحتضن حجارة منزله الذي تكوم على الأرض، كما تتكوم نساء غزة في المشاهد الجنائزية التي أصبحت مألوفة لعيوننا الوقحة، مألوفة لقيمنا المهزومة، لعروبتنا المزورة التي ألقت آخر سيوف خالد بن الوليد تحت سنابك دبابات جاست خلال الديار، وداست على أجساد الأطفال.
سأكتب اليوم بلغة الروح، لغة القلب، لغة شعراء البكائيات القديمة، لغة المراثي، مراثي المدن، مراثي القيم والأخلاق والرجولة والضمير والعدالة المذبوحة. سأكتب بتدفق دم الأطفال الحار، بنبرة صراخ الأمهات، بأنّةٍ مكتومة لوائل الدحدوح، وهو ينحني على جسد ولده المسجى، بدموع كل الأمهات، بكل الدم الذي نزف من أكثر من أربعين ألف جسد، ليشكل المحبرة الأكبر لتوثيق أكبر جريمة يشهدها القرن الحادي والعشرون.
سأكتب اليوم بتلقائية، ولن أنقح أو أراجع، تعبت من التنقيح والمراجعة ومن عقلي الذي أريد أن أضعه جانباً، سأكتب بالقلب، وللجريدة الحق في نشر المقال أو منعه، أو نقله إلى مكان آخر. سأكتب على طبيعتي، لأننا عندما نكتب خلاف طبيعتنا نتعب، عندما ندعي برود الأعصاب فيما الحريق ينسفح نكذب، عندما نكتم قصيدة هجاء تعتمل في داخلنا منذ عقود، هجاء لنا، لكم، لهم، لكل ضمائر المتكلم والمخاطب والغائب، عندما نكتم هذا الهجاء الذي يجب أن نقذف به في وجه هذا العالم القبيح، عندما نكتمه فإنه ينمو داخلنا كعشب ضار لا يلبث أن يلتف حول شجرة أرواحنا حتى يتلفها، وهذا ما أشعر به إزاء عقود من القهر والهزائم المتراكمة، إزاء وقاحة عالم له لسان قديس ويد شيطان، ولذا قررت هنا أن أكتب، لا أكتم، كي لا تأكل الكلمات جدران الروح التي أوشكت على الانهيار، كما تنهار مساكن غزة على رؤوس أهلها.
سأكتب الآن على السجية، سئمت تقمص دور الكاتب الصحافي، والمحلل السياسي، لدرجة أنني عندما أرى المعلقين على الشاشة بصفة محلل سياسي ينتابني شعور بأن وظيفة التحليل السياسي تشبه وظيفة تحليل/تبرير الجريمة، بما أننا نقدمها للناس بقلب جامد، لا يرى في الجريمة إلا لغة الأرقام والحساب، بعيداً عن المعنى الكبير الذي يتفجر مع الدم المتدفق من أكثر من أربعين ألف لحن جنائزي في غزة.
بعد كل هذه النشرات، وكل هذا التحليل المصاحب، وكل الكلام الذي ملأ الآفاق لم يعد لديَّ القدرة على تقمص البرود والموضوعية والعقل والمنطق والتحليل السياسي، ولا لعب دور مصور صحافي يريد أن يفوز بجائزة عالمية في التقاط أول صورة لروح طفل صغير، لحظة صعودها إلى السماء، دون اعتبار لما تحمله اللحظة من ألم للطفولة والأمومة والأبوة، ألم لامس شغاف صخرة صماء، دون أن يصل لقلوب تجار السلاح والحروب.
وليس أقسى من مطالعة وجوه المعلقين السياسيين إلا رؤية وجوه الساسة وهم يحولون دماء الأطفال في غزة إلى كاش في حسابات بنكية، ويحولون غزة إلى مزاد كبير للبيع الرخيص، مع أن المعروض في المزاد أجساد مبعثرة لا يتورع المزايدون عن تسليعها للمرابحة والاستثمار في بنك الدم، تماماً، كما تصور منظمات الإغاثة أجساد الجياع وتضعها على ملصقاتها الدعائية.
وفوق هذا فإن الأقسى هو رؤية وسيط سلام في حرب بين طرفين يمد المعتدي بالسلاح؟ ولكن هل يجوز أن نقول إن هناك طرفين في حرب أحد طرفيها طفل فقد كل أفراد أسرته، ونام على حصيرة فوق ركام منزله؟! ومن يصدق حرص مالك مصنع السلاح على تحقيق السلام؟ وذلك الذي زار القتلة مسافراً بين صناديق الذخيرة، كيف يجرؤ على الدعوة لوقف إطلاق النار؟! وأية وقاحة تمتلكها «أف 16» التي ألقت أطنان اللهب على غزة، ثم زعمت توزيع المساعدات الإنسانية على أهلها؟!
لقد كشفت الحرب على غزة عن توحش المدنية، كشفت كيف يمكن للإنسان أن يتحول إلى آلة حرب، كيف يمكن أن يكون حيواناً بربطة عنق أنيقة، كيف يقتل طفلاً بصاروخ، ثم يقول للمحكمة إن الطفل كان يحاول أن يطلق النار على حمامة اسمها «أف 16» رغم أنها قتلت كل أفراد أسرة طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره، قبل أن تلحقه بهم.
إنه عالم مجنون، متصحر، شرع القوانين لتطبق على الضعفاء وتحمي الأقوياء، وبنى المؤسسات الدولية لتكون وسيلته في ممارسة السحر والدجل والشعوذة، عالم يقف مع القاتل، لأنه قوي، ويتهم الضحية لمجرد أنها ضعيفة، ولأن هذا العالم بلا منطق، ولا عقل، لذا لم تعد لغة التحليل والعقل والمنطق وسيلة ناجعة في إيصال رسالة غزة إليه، حيث يفوق الموصوف صياغات الوصف، وتظهر الحقيقة أغرب من الخيال.













