هذا السؤال يراود جميع اليمنيين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم، ولكل طرف إجابته الخاصة حتى لو لم يصرح بها، فالحوثيون يقولون في قرارة أنفسهم، إذا لم تتدخل السعودية ما كنا الآن نتحكم بالسلطة وما استطعنا أن نحشد الناس إلى الجبهات تحت ذريعة مقاومة العدوان، أما الذين التقطتهم السعودية ليكونوا جسرا لها إلى اليمن فيقولون، لو لم تتدخل السعودية، لكان الحوثي اليوم يسيطر على كامل اليمن، بينما بقية الشعب اليمني وهم الأقرب إلى الصواب، يقولون لو لم تتدخل السعودية، لكان الحوثي قد هزم شر هزيمة ولما وجد له مبررا لقمع اليمنيين والتنكيل بهم بذريعة العدوان، ولما كان الحثالة يتحكمون بنا اليوم.
الذين يزعمون أن تدخل السعودية حد من سيطرة الحوثيين، هؤلاء فرطوا بفرصة إقامة الدولة ولن يجود الدهر بفرصة أخرى كتلك التي أضاعوها، فقد سلموا القرار للسعودية وأهدروا السيادة الوطنية وفرطوا بالمؤسسات، والسعودية اكتفت بمجموعة من اللصوص والفاسدين، الذين يمدحون السعودية علنا وفي الغرف المغلقة يشكون ضعفهم وقلة حيلتهم وأنهم لا يمتلكون القرار وكل ما يجري ليس برضاهم وليس بأيديهم.
في بداية الحرب، كان البسطاء منشغلين بمحاربة الحوثي، وكانوا يحققون تقدما ملموسا مصحوبا بدمائهم وأرواحهم، بينما الشرعية المصنوعة على يد السفير السعودي محمد آل جابر كانوا مشغولين بأمور شخصية وعاطفية، حتى أن وزير الإعلام تغنى بمحمد بن سلمان.
قائلا: فارس في مشيته، فارس في نظرته، فارس وهو في الأصل فارس، فتمت مكافأته بأن أضيفت له وزارة الثقافة والسياحة، وحينما تسأله عن سبب غياب السياحة في اليمن، يقول لك، نحن في حالة حرب، طيب وأين دور السعودية التي لولا هي لكان الحوثي يحكم اليمن، ها أنتم لا تستطيعون حكم اليمن، فالحوثي هو المتحكم بالقرار وهو الذي تتفاوض معه السعودية اليوم.
أقول فرصة إقامة دولة في اليمن كانت سانحة، وخيارا كان متاحا ومناسبا لجميع اليمنيين، ولكن أضاعها الذين أصروا على تصحيح الماضي، بدلا من صناعة المستقبل، خاصة اليسار بوجهيه القومي والماركسي الذين وجدوا فرصة للتنفيس عن الأحقاد التاريخية التي يعانون منها ويظهرون أنفسهم بمظهر الأبطال الذين لا يشق لهم غبار ويتباهون بمنجزات متخيلة، أكثر هؤلاء انحازوا للإمارات في مواجهة الإصلاح ومعهم بعض المؤتمريين ، وبعض الإصلاحيين دخلوا في مواجهة مع بعض المؤتمريين ، ومن هنا بدأت الانشقاقات داخل الشرعية وخارجها، وتناسلت المليشيات وتراجع دور الجيش الوطني.
والسؤال، هل ستسنح فرصة أخرى لإقامة دولة في اليمن؟
والإجابة، ربما ولكنها لن تنجح ما لم يقودها المخلصون لوطنهم، لا أصحاب المشاريع الشخصية والعائلية، الذين يعتبرون السعودية والإمارات صمام أمان لبقائهم على رأس السلطة، ولا يهمهم بعد ذلك الشعب الذي قتله الجوع، ولا حجم الأذى الذي يتعرض له المواطن الواقع تحت سلطة الحوثي، أو تحت سلطة الشرعية الافتراضية.
فلولا تدخل السعودية لما استمر الحوثي كل هذه الفترة، ولما كان على رأس السلطة مجموعة من اللصوص الذين صنعتهم لتمثيل اليمن الذي لم يبق منه شيئا، سوى هؤلاء الموميات التي لا يهمها سوى مرتباتها الشهرية، يتعاملون معنا على أننا أشياء وليس بشرا، وحرموا المواطن من أبسط الأشياء، حرموه من الأمن اليومي ومن الوظيفة أو مصدر للعيش وبناء بيت وعائلة ومنعوه من الاستقرار في وطنه.
فبعد هذا نستطيع أن نثير السؤال ونقول، هل التدخل السعودي كان لصالح بناء الدولة، أم كان لصالح الحوثيين والموميات المحنطة المسماة سلطة الشرعية؟
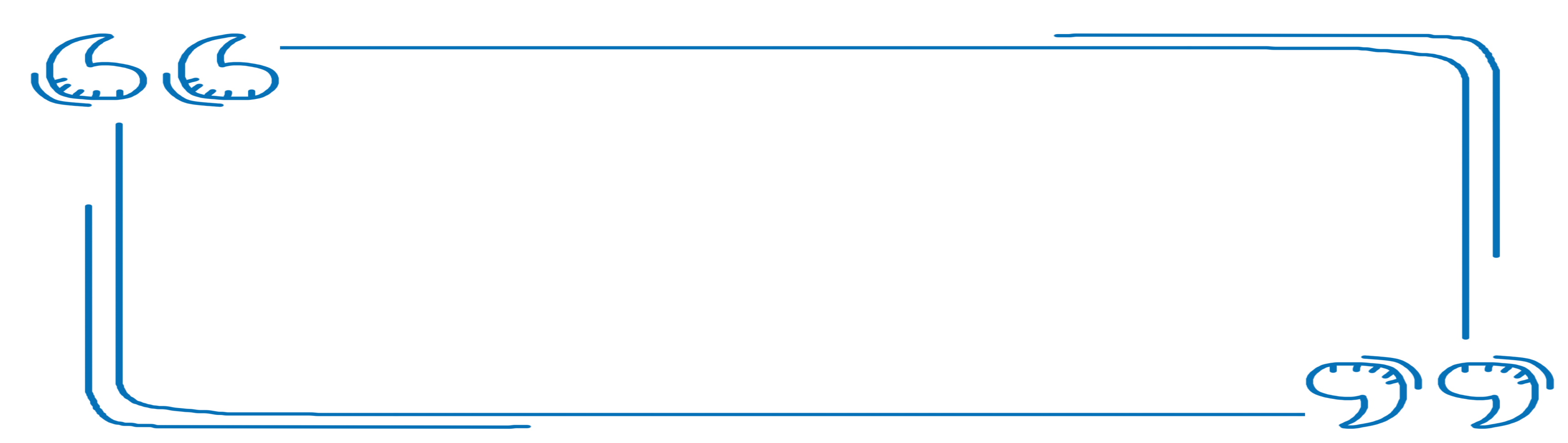
30 أبـــــريل 1973
حسن عبدالوارث
لا أذكر فترة طال أمد استقرارها وازدهارها في اليمن - منذ ثورة 1962 واستقلال 1967 - من دون أن تُعكّر صفوها أحداث وحوادث ومشاهد الدم والبارود!
ولا أذكر حاكماً يمنياً - في المساحة الزمنية ذاتها - لم يكن مصيره، إما مقتولاً أو معتقلاً أو فارّاً ذليلاً، وإما مخفياً أو منفياً، مشنوقاً أو محروقاً أو مُثلّجاً تحت الصفر!
ولا أذكر نظاماً سياسياً في هذا البلد لم يشهد ظاهرتَيْ: الاغتيال، والتعذيب، في الأنظمة "الرجعية" والأنظمة "التقدمية" على السواء، شمالاً وجنوباً معاً!.
اليوم - مثالاً فحسب - تحضر الذكرى الخمسون لفاجعة طائرة الديبلوماسيين. فمثل هذا اليوم بالضبط - منذ نصف قرن بالتمام والكمال - تمَّ نسف إحدى طائرتين في الأجواء اليمنية، خلال رحلة داخلية بين محافظتَيْ شبوة وحضرموت، كانتا تحملان أكثر من 20 ديبلوماسياً وكادراً سياسياً وإدارياً اشرافياً.
كان معظم هؤلاء يعمل في ديوان وزارة الخارجية أو في السفارات اليمنية - الجنوبية حينها - لدى الخارج، شهدوا يومها المؤتمر الأول للديبلوماسيين اليمنيين في مدينة عدن - العاصمة - في منتصف ذلك الشهر من تلك السنة، وفي مقدمتهم معالي وزير الخارجية محمد صالح عولقي.
ومنذ اللحظات الأولى لهذا الحادث الأليم، أدرك الجميع تقريباً أن الحادث مُدبَّر، لاسيّما أن الضحايا كانوا - جُلّهم انْ لم يكونوا كلهم - من الكوادر المحسوبة سياسياً على الرئيس المُنقلَب عليه في 22 يونيو 1969 (قحطان الشعبي)، أو من غير المَرضي عنهم من النظام اللاحق (ترويكا: سالمين، فتاح وناصر).
إنني لا أكتب بهذا الشأن من أجل نبش ملفات الماضي - المغلَقة كالعادة - لمجرد النبش، أو لإذكاء نار الفتنة - التي لم تخمد يوماً أصلاً - إنما لأن فترة نصف قرن من الزمان كفيلة بإظهار نتائج التحقيقات التي جرت يومها لكشف حقائق وملابسات الحادث. وهذا حق الأجيال - السابقة واللاحقة - على الدولة، وعلى التاريخ، وعلى الضمير الإنساني.
إن اللجنة التي كُلّفت بإجراء تلك التحقيقات - يومها - مُطالَبة بقول ما لم تقُل حتى الآن بهذا الخصوص، أولاً: من أجل الحق في معرفة الحقيقة، وثانياً: لاستخلاص الدروس والعِبر من شواهد الماضي، وثالثاً: وفاءً لأرواح من قضوا في هذا الحادث الأليم، والاعتذار العلني لعائلاتهم وجبر الضرر الناتج عن ذلك الفقد الجسيم.
إن نصف قرن كفيل بإماطة اللثام عن الأسرار التي اكتنفت خبايا وخفايا ذلك الحادث - الجريمة - الكارثة. لاسيما أنني أعتقد جازماً أنه إذا كان غالب من يدري ماذا حدث يومها، ولماذا وكيف، قد رحل إلى العالم الآخر، فإن بعضهم لايزال على قيد الحياة وقادراً على الكلام، ولكنهم - حتى هذه اللحظة - اختاروا الصمت والانضمام إلى طابور الشياطين الخُرس!
كنا نظن - وبعض الظن إثم بالتأكيد - أن تقييم ونقد الأحداث والحوادث التي شهدتها الساحة السياسية اليمنية من شأنه أن يحِلّ أو يحِدّ من ظاهرة استخدام العنف في الخلاف أو الصراع السياسي، وهو ما صار يُعرف بظاهرة التصفيات الجسدية، وهي ظاهرة يمانية تليدة، مستمرة بوتيرة شديدة منذ فترة مديدة.
حتى يوم سقوط الأنظمة الشطرية من روزنامة التاريخ وقيام دولة الوحدة في 22 مايو 1990، أثمْنا باعتقادنا أن شواهد الرعب والدم والبارود قد ولّت، ولو إلى حين بعيد. غير أن هذه الشواهد عادت لتعُمّ البلاد، بعدها بأقل السنين وبأسوأ الصور.
وفي هذه اللحظة بالذات، أجدني أقف دقيقةً حِداداً على أرواح ضحايا 30 أبريل 1973، مستذكراً رفيقهم في هذا الحادث الكارثي الأليم، الأديب محمد عبدالولي، عبر عبارته الخالدة الأليمة للغاية، التي جاءت على لسان أحد أبطال إحدى رواياته، حين قال بالنص: "هناك سِرٌّ ما في بلادنا هذه. إنها جرداء وقاحلة، لكن الأمل في ألاَّ يقتلنا هؤلاء الذين لا قيمةَ إلاَّ لبندقياتهم"!
وتشاء حماقة الأقدار أن يقترف "هؤلاء الذين لا قيمة إلاَّ لبندقياتهم" جريمة قتل عبدالولي نفسه.
* موقع قناة بلقيس













