في زمن مضى، كُنا نجد متعة في المناكفات والملاسنات، التي تنشأ بين المثقفين.
كان زمناً هانئاً.. وكان يمناً هادئاً..
وكنا نطرب لمثل هذه الصغائر - التي تبدو كالكبائر حين تبدر من المثقفين! - من منطلق كسر الرتابة وهدم السأم.
حتى حين كانت تلك الحرائق تبدأ في الانطفاء، نسعى جاهدين للنفخ في جمرها لتشتعل من جديد. وكنتُ واحداً ممن يجيدون تأجيج الأمور قبيل أن تخمد، حتى إن نفراً من الزملاء والأصدقاء اتفقوا على تسميتي: حسن عبدالكوارث!
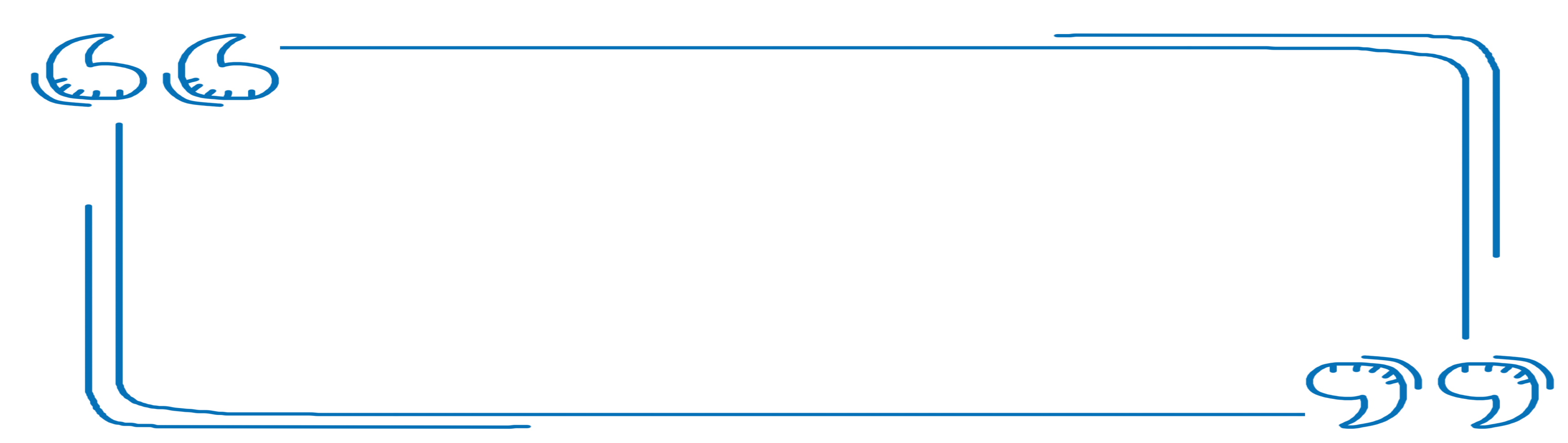
كانت تلك الحماقة محمودة إلى حدٍّ ما، في ظل انسجام الأوضاع على ملامح الاستقرار، باعتبار إن البذاءة مع الهناءة لا ضير فيها ولا ضرر، وكما قال المثل اللحجي: ما ( ... ) إلاَّ من سلى!
أما اليوم، في ظل هذا الركام الهائل من الدماء والأشلاء والخرائب والحرائق الممتد على طول الوطن وعرضه.. هل يستقيم عود صغائر المثقفين هذه؟
لا أعتقد.
كان في ضواحي عدن أيام زماااان، موقع يدعى "السيسبان" تقطنه بائعات الهوى. وكان المجتمع الصغير ذاك يتقاطع إجمالاً مع هوية الثقافة وبورتريه المثقفين..
أما ما يحدث اليوم في بعض أوساط المثقفين فليس سوى "سيسبان" جديد وحقيقي!
إن المثقف، الذي يبيع أهله ووطنه بخمسين من فضة، لا ينتمي إلى فئة المثقفين ولا واقع الثقافة البتة، بل ينتمي - نهجاً وعضوياً - إلى فئة بائعات الشرف - لا الهوى، وواقع الانحلال الرخيص، أو الانحطاط بمعنى المفردة!
رحل من ذاك الزمن - ومن كل زمن - أجمله وأنظفه، حتى السيئات والسيئين بدت اليوم كالصالحات والصالحين. ندري أنه لم يعد ثمة مكان للأنبياء والأولياء، لكن المصيبة أنه لم يعد ثمة مكان للمثقفين في هذا الزمن واليمن، زمن ويمن الحرب. إن السيسبان والديدبان صارا معنى واحداً لمفردتين سيئتي السمعة في كشكول البلاد ودفتر الأحوال اليمنية، والمثقف يتقرفص بين الاثنتين، وفي الواقع هي نصف قرفصة!
ومؤخراً، وفي الشهور القليلة الماضية، رحل عن هذه الدنيا عدد غير قليل من الأصدقاء والزملاء والرفاق لم أشهد في هذا الزمن أشرف منهم ولا أنظف، بعضهم إثر مرض عضال استحال احتواؤه بسبب ضيق ذات اليد، أو انسداد ممر الخروج إلى بلاد الله الحقيقية؛ جراء تبعات هذه الحرب الملعونة.. وبعضهم قضى بعد معاناة مريرة مع موبقات هذا الزمن الحقير الذي أحال الميسور معسورا والمجبور مكسورا بقدر إحالته الشلافيت والهلافيت تماسيح وخراتيت.. ورحل الآخرون فجأة وبدون سابق إنذار، أو حتى تلميح، بعد أن أيقنوا أن المقبرة خير عزاء عن وطن صار في خبر كان.
وكلما جاءني نبأ رحيل أحدهم لا أجد بعد الدعاء له بالرحمة والمغفرة سوى كلمة "ارتاح".. واليمن هو البلد الوحيد على وجه الأرض، الذي تسمع فيه هذه الكلمة، تعليقاً على وفاة أحدهم!
حقاً، كم أحسد من يموت في هذه الأيام، نافذاً بجلده من بؤرة الجحيم المقيم إلى دوحة النعيم الخالد. فالعاقل وحده يدرك تماماً أن مأساة اليمن ما تزال في مرحلة جهنم، وهي أولى الدرك الأسفل من الجحيم، أي أنه ما تزال ثمة درجات أخرى أشد عذاباً وأسوأ مقاماً وأفدح مصاباً، فثمة لظى وسقر والحطمة والسعير، وغيرها حتى تصل إلى الهاوية، وما أدراك ما الهاوية، وهي الدرجة الأخيرة من الدرك الأسفل، التي سنصلها قريباً بإذن الله، وبفضل هؤلاء وأولئك الأوباش الأنجاس الذين ما عرفوا الله ولا اللات ولا طاولهم جن الأشتوت الأشتات.
لقد اختزل مثقفو هذي الحرب هذا البلد بمشهد لا يتكرر في التاريخ:
طلقة في الظهر.. وخطوة إلى الخلف.. وصُرَّة في الجيب.
يارب، شُل أمانتك. قد تأخر الوقت كثيراً.













